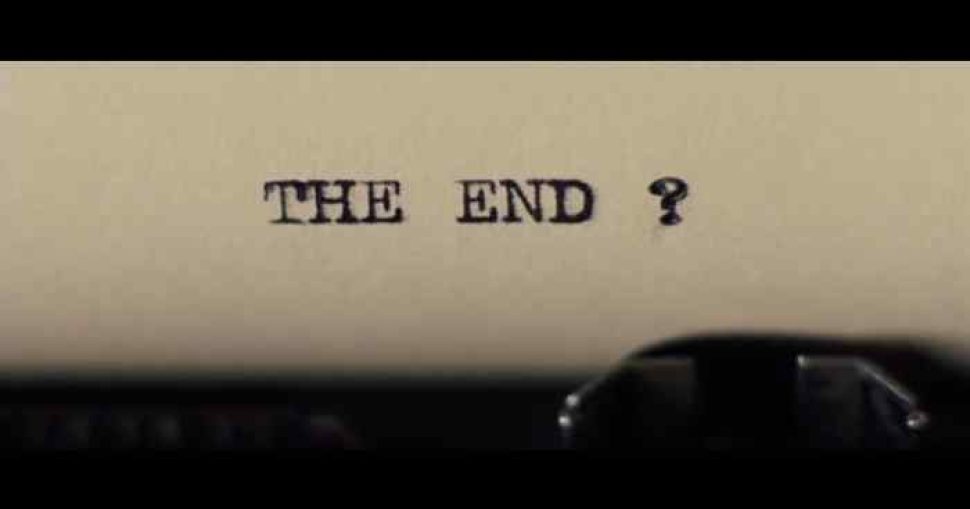«الموت فنٌّ أتقنه بشكل استثنائي»
– سيلفيا بلاث
كمعبودة جماهير عُرِفَ عنها طريقها اللاهث نحو الفَنَاء يومًا بعد يوم؛ حيث تُبَدِّل شَعرها، ثم تتسلق بعناء حتی تنحني للجمهور تحيَّةً، تموت الرواية بهذا الشكل. ولمدة طالت، أضحی الموت جزءًا لا غنی عنه من مَسْرَدها، محال أن يُفصَل زيفه عن أدائها.
كما كان للأوبرا، نحن نناقش «موت الرواية» في حَضْرَة الفن. وفي حَضْرَة الواقع، نحن لا نترقب أن تنقطع الروايات عن المطابع أكثر من ترقبنا لإجلاء المُغنِّي من علی المسرح في عربة الموتی. الرواية كتاب. الرواية مُناجاة وموتها فكرة مجازيّة بُجِلَت بالرغم من عدم إبتداعها لجثة من قبل.
لكننا نقول هذا لنتجنب السؤال عن سبب وجود سؤال. منذ «آرثر رامبو»، مِزيّة الأدب كانت احتقار الأدب. كما أشاع المستقبليون والسرياليون والدادائيون، أن هذا الاحتقار جاء من الاعتقاد بأن الرواية كانت صيغة من القرن التاسع عشر تعني «بُرجوازيّة»، وهي كلمة تُشير -في ذلك الوقت- لكل شيء رَّثٍّ وفاسد.
كما في الماركسيّة حيثما اكتَسَبَت الكلمة تلك النغمة، كان هنالك في أساس الخطاب فكرة تقدميّة. نقرأ «أميرة كليفز» لـ«مدام لافاييت» التي أُصدِرَت في 1678م، فنجد الشخصيات محصورة وجامدة وكأنها في إفريز. «ديزي ميلر» لـ«هنري جيمس» عام 1878م، نجد شخصياتها كلها متحركة، كلها حَيّة.
اُشتقَت فكرة عكس الرواية للحياة من مقاربة العلم لتفنين التاريخ، المحاولة التي شهدت رموز مُحَرَرَة من الكاتدرائيات المتحجرة والخلفيات المُذَهبَة تتلبس أجساد يمكن تصديقها على نحو متزايد. ذلك التطور كان حقيقيّ، وأساطير القرن التاسع عشر من الراوئيين -بلزاك وديكنز ودوستويفسكي- أنتجوا لوحًا فنيّةً ليست فقط عن أفراد بل عن مجتمعات بِأسْرِها.
ثم تَعثَّر التقدم في القرن العشرين. حتی أن أعظم الأحداث توحشًا من القرن التاسع عشر بدت قابلةً للتشكل الأدبي، أما الخنادق وغرف الغاز من القرن العشرين بدت نوعًا ما تتعمد رفض أي محاولة للمعالجة الفنيّة؛ أنها رفضت اللغة نفسها.
لذا كانت الرواية بشكلها القديم قد ماتت بالفعل. ولكن تلك كانت «الرواية». أصبحت الروايات نفسها مَرِنةً جدًا بحلول القرن العشرين حيث فقدت الكلمة معناها تقريبًا. ما العلاقة بين «البحث عن الزمن المفقود» لـ«مارسيل بروست» التي تعدت ال3000 صفحة و«قنديلة البحر» ذات الـ80 تقريبًا لـ«كلاريس ليسبكتور»؟ كلاهما روايات عصريّة عظيمة. وهنا ينتهي التشابه.
يمكن أن تكون للرواية حبكة كما عند «بروست»، أو ألا تكون لها كـ«ليسبيكتور». ولم تُبتدع هذه المرونة في القرن العشرين، فعمَّ تَدُور «موبي ديك»؟ تلك الكتب عصريّة لأن كتابها كانوا كذلك، وقد أثبتوا أن من يُنتج الرواية ليست بضعة المبادئ الجامدة بل الروائي: شخص كالآخرين يتغير مع الوقت ثم يموت.
طالما هناك رسامون، تجد اللوحات. طالما هناك موسيقيون، تجد الموسيقی. اللوحات التي نراها، الموسيقی التي نسمعها، لَمّا كانت أن تعتبرها «مادام لافاييت» كذلك. كذا الحال للروايات التي نقرأها. ولكن هذا لا يعني أنهم لم يتطوروا منذ أيام «موزارت» و«رامبرانت».
الرواية لا تعكس الحياة بل إنها الحياة، النظريات تموت بما فيها نظريات التقدم ومفاهيم «الرواية» حيث إنهم ينهارون، والذي يبقی هو سِمَة الحياة بداخل الكتاب جماله الذاتيّ. وبالرغم من أن مؤلفيهم ماتوا كالأوقات التي صاغتهم، فإن «أميرة كليفز» تتسم بالجمال، و«قنديلة البحر» كذلك، و«موبي ديك» أيضًا، وهو جمالهم ما يجعلهم أحياء.