يعد كتاب ماكس فيبر الشهير «الأخلاق البروتستانتية وروح الرأسمالية» أكثر الأعمال القانونية التي أُسيء فهمها والتي تُدرّس وتشوّه وتوقّر باستمرار في مختلف الجامعات عبر العالم. لا يعني هذا القول بأنّ المعلمين والتلاميذ أغبياء، بل ربما يعني أنّه نص متماسك بشكل استثنائي والذي يتناول مدى من الموضوعات في حقل معرفيّ واسع، والذي كتبه مثقف مطلق يتربع على قمة مجاله. لقد كان ليُصعق إثر اكتشاف أنّ كتابه يُستخدم كمقدمة مبدئية لعلم الاجتماع للطلبة غير المتخرجين أو حتى أطفال المدارس.
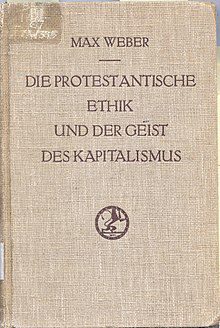
إننا نستخدم كلمة «الرأسمالية» اليوم كما لو كان معناها بديهيًا، أو كما لو كان مصدرها ماركس، لكن عدم الاهتمام هذا يجب وضعه جانبًا. كانت «الرأسمالية» كلمة فيبر وقد عرّفها بالطريقة التي رآها مناسبة. معناها الأكثر عمومًا كان ببساطة الحداثة نفسها؛ حيث كانت الرأسمالية «القوة الأكثر حتمية في حياتنا المعاصرة». بشكل أكثر تحديدًا، تحكمت الرأسمالية وولّدت «الثقافة الحديثة»، والتي بدورها تعدُّ نظام الأخلاقيات الذي عاش به الناس في الغرب خلال القرن العشرين، والذي يعيشون به في الكثير من أجزاء عالم القرن الحادي والعشرين. كنتيجة لذلك، فـ «روح» الرأسمالية هي أيضًا نظام أخلاقي، رغم أن ذلك لا يدع مجالًا للشك أن العنوان كان ليكون مبتذلًا بعض الشيء إذا كان أُطلق عليه الأخلاق البروتستانتية وأخلاق الرأسمالية.
هذه «الأخلاق» المعاصرة أو نظام الأخلاقيات كان مختلفًا عن أي نظام آخر سبقه. افترض فيبر أن كل الأخلاق السابقة كانت دينية؛ والتي هي عبارة عن نظم أخلاقية مقبولة بدلًا من كونها الأطروحات الغامضة التي يصنعها رجال الدين والفلاسفة. زوَّدت الديانات الناس برسالاتٍ واضحة عن كيفية التعامل في المجتمع وفقًا لمعايير إنسانية واضحة، رسالاتٌ عوملت على أنها أمور أخلاقية مطلقة وملزمة لجميع الناس. في الغرب كان هذا يعني المسيحية، ووصيتها الاجتماعية والأخلاقية الأكثر أهمية جاءت من الكتاب المقدس: «أحبب جارك». لم يكن فيبر ضد الحب، لكن فكرته عن الحب أنّه شيء خاص، أي مجال للحميمية والجنسانية. كمرشد للتصرف الاجتماعي في الأماكن العامة، «أحبب جارك» هي هراءٌ بالطبع؛ وقد كان هذا سببًا رئيسيًا في كون ادعاءات الكنائس في مخاطبتها المجتمعات الحديثة بتعابير دينية أصيلة كانت هامشية. لم يكن فيبر ليتعجب من الجولات الطويلة التي كانت تستمتع بشعار «الإله محبة» في الغرب في القرن العشرين -حيث كان نشاط عملهم قد بدأ بالفعل في أيامه- ولا من أنَّ نتائجها الاجتماعية كانت شديدة المحدودية.
الأخلاقيات أو النظام الذي سيطر على الحياة العامة كان شديد الاختلاف. على قمة كل الصفات كان هذا النظام غير شخصي بدلًا من كونه شخصيًا. بالوصول إلى أيام فيبر، فإنّ الاتفاق على ما هو صحيح وما هو خاطئ للفرد كان قد تفكَّك. حقائق الدين -الذي هو أساس الأخلاقيات الكلاسيكية- كانت تخضع للاختبار، والعادات التي لطالما كانت مقدسة -مثل تلك المتعلقة بالجنسانية والزواج والجمال- كانت أيضًا تتفكك. (إليك لمحة من الماضي: من يجرؤ الآن على أن يساند فكرة مُلزمة للجمال؟). كانت القيم تصبح بشكل متزايد ملكية للفرد لا للمجتمع. لذا ف بدلًا من التواصل الإنساني الدافئ المبني على فهم متشارك وواضح بالحدس للصواب والخطأ، كان التصرف العام باردًا ومتحفظًا وقاسيًا ويقظًا؛ وكان يحكمه ضبط نفس شخصي شديد. التصرف الصحيح يكمن في اتباع العمليات الصحيحة. بوضوح شديد، كان التصرف الصحيح هو إطاعة حروف القانون (فمن كان ليستطيع الجزم بكينونة روح القانون؟) وقد كان هذا عقلانيًا. كان هذا منطقيًا وثابتًا ومتسقًا، وعلاوة على ذلك فقد أُطيعت حقائق حديثة لا يمكن التشكيك فيها كقوة الأرقام والقوى السوقية والتكنولوجيا.

كان هناك أيضًا نوع آخر من الانفصال بجانب ذلك الخاص بالأخلاقيات التقليدية. لقد جعل الانتشار الواسع للمعرفة والانعكاسات عليها، جعل ذلك معرفة وإحصاء شخص واحد لهذا كله مستحيلًا. في عالم ليس من الممكن استيعابه بشكل شامل، وحيث لم تكن هناك قيم مُتشاركة بشكل عالمي؛ تشبّث معظم الناس بالمشكاة التي كانوا أكثر التزامًا بها: وظيفتهم أو مجال عملهم. لقد عاملوا عملهم على أنّه دعوة ما بعد دينية، وعلى أنّه «غاية بحد ذاتها»، وباعتبار أنّه إذا كان للخلق أو الروح المعاصرة أساس مطلق، فإنّ العمل هو ذلك الأساس.
واحدة من أكثر العبارات المبتذلة عن فكر فيبر هو القول بأنّه بشّر بأخلاقيات للعمل. يعد هذا خطأً. لم يرَ فيبر شخصيًا أي فضيلة في العرق -لقد ظنَّ أنَّ أعظم أفكاره جاءت إليه حينما كان يسترخي وهو يدخن السيجار- وإذا كان نما إلى علمه أنّه سيُساء فهمه بهذه الطريقة لكان أشار إلى حقيقة أنّ القدرة على العمل الشاق كانت شيئًا لا يميز الغرب المعاصر عن المجتمعات السابقة ونظمهم القيمية. على الرغم من ذلك، فإن فكرة أنّ الناس أصبحوا -وبشكل متزايد- يعرَّفون بواسطة التركيز ضيق الأفق على عملهم كان شيئًا اعتبره فيبر عميق الصلة بالحداثة وسمة لها. الأخلاقيات المهنية ضيقة الأفق كانت شائعة لدى رواد الأعمال والقوى العاملة الماهرة عالية الأجر، وقد كان هذا المزيج هو ما أنتج موقفًا حيث «الفضيلة العليا» هي صنع المال والاستمرار في صنع المزيد منه بدون أي حد. هذا هو الشيء الجاهز للتعريف به كـ «روح» الرأسمالية، لكن من الواجب التشديد على أنّ هذا ليس مجرد خُلُق بسيط من الطمع والذي -كما أدرك فيبر- قديم قدم الوقت ودائم.
في واقع الأمر توجد مجموعتان من الأفكار هنا، على الرغم من أنّهما يتقاطعان. هناك واحدة عن ما يحتمل أن يكون عمليات عقلانية عالمية -مثل التخصص والمنطق والتصرفات الثابتة الموحدة- وأخرى هي أقرب للاقتصاد المعاصر، والذي تشكّل أخلاقيات العمل جزءًا أساسيًا منه. الموقف المعاصر كان نتاج الالتزام ضيق الأفق بوظيفة الشخص المحددة تحت مجموعة من الشروط؛ حيث هُجرت محاولة فهم الحداثة بشكل شامل من قبل معظم الناس. كنتيجة لذلك أصبحوا غير متحكمين في مصائرهم، بل محكومين بمجموعة من العمليات العقلانية وغير الشخصية والتي شبهها فيبر بقفص حديدي أو «إسكان من الفولاذ». مع الأخذ في الاعتبار الأساسات العقلانية وغير الشخصية، أصبح هذا الإسكان بعيدًا كل البعد عن أي مُثُل إنسانية كالدفء أو العفوية أو فتح مجال للآفاق. غير أنَّ العقلانية والتكنولوجيا والقانونية أنتجت أيضًا منتجات مادية صالحة للاستهلاك الضخم بكميات غير مسبوقة. لأجل هذا السبب، كان من غير المرجح أن يغادر الناس هذا الإسكان -رغم كونهم قادرين دائمًا على فعل هذا إن أرادوا- «حتى يحترق آخر قنطار من الوقود الحفري».
هذا هو تحليل قوي للغاية، وهو يخبرنا الكثير عن الغرب في القرن العشرين وعن مجموعة من الأفكار والأولويات الغربية التي استأنفها العالم بسعادة متزايدة منذ عام 1945. لا تنبع قوة هذه التحليل ممما يقوبه ببساطة، بل لأن فيبر حاول موضعة الفهم قبل الحكم، وأن يرى العالم ككل. إذا كنّا نرغب في الذهاب لما يلحقه فكريًا، فهذا ما يتوجب علينا فعله.

