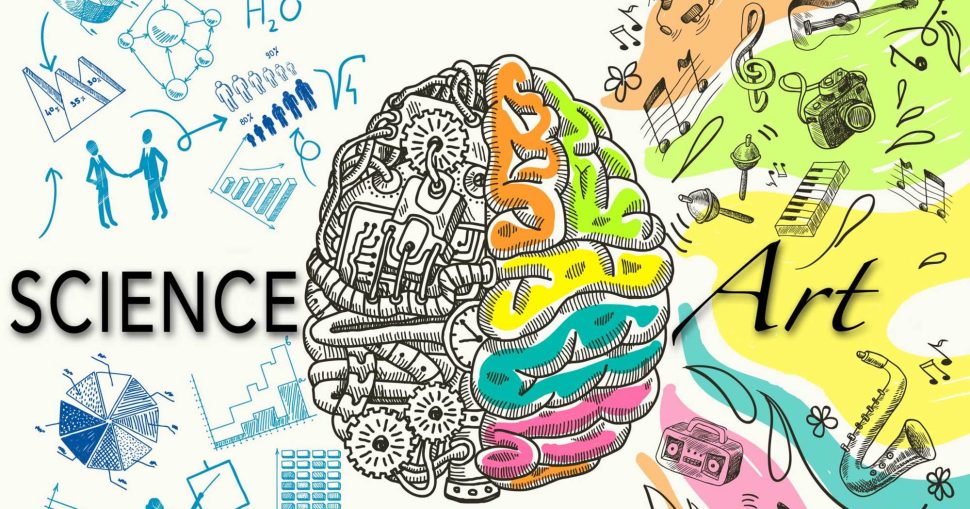قالت الحية للحسون: «ما أجمل طيرانك أيها الحسون! ولكن حبذا لو أنك تستطيع أن تنسل بين ثقوب الأرض وأوكارها، حيث تختلج عصارة الحياة في هدوء وسكون».
فأجابها الحسون: «إي، وربي! إنك واسعة المعرفة بعيدتها؛ ولكن حبذا لو أنك تطيرين».
قالت الحية: «أعرف هيكلاً مطمورًا تحت تراب الأرض، لم يهتدِ إليه باحث أو منقب بعد، هو من بناء الأزمنة الغابرة، وقد نُقشت عليه أسرار الأزمنة والأمكنة..»
فأجابها الحسون قائلاً: «بلى، أيتها الحكيمة العزيزة، فإنك لو شئتِ لاستطعتِ أن تكتنفي بلين جسدك جميع معارف الأجيال. ولكنكِ، واأسفاه، لا تقدرين أن تطيري!»
فاشمأزت الحية إذ ذاك من حديثه، وارتدت إلى وكره تتمتم في ذاتها قائلةً: «قبحه الله من غِرِّيد فارغ الرأس!»
أما الحسون فطار وهو يغني بأعلى صوته: «واأسفاه، إنك لا تغردين! واأسفاه، يا حكيمتي، إنكِ لا تطيرين!»(1)
أصوات متسائلة وأخرى مستنكرة: ما فائدة الرواية؟ ولماذا نقرأ الشعر؟ بحيث صار الأدب والفن عامةً موضع تهديد، وأصبح البعض يبحث عن هدف للعمل الفني، وآخرون يتجهون لفن «هادف»، بحيث يتم تطعيم الفن بالمعرفة والعلوم بشكل يؤثر على جماليته فرادته، ينتشر هذا الفكر مثل النار في الهشيم بين الأجيال الصاعدة، خاصةً في ظل نظام تعليمي هدفه التلقين، وآباء يريدون لأبنائهم الوصول لدرجات علمية تضمن لهم يدًا عالية وحياةً رغيدة. فأين الفن من كل ذلك، وهل يجب أن نبحث عن فائدة له تبرر وجوده، أم أن ندافع عن وجوده اللاهادف؟
بالمصادفة رأيت مقطع فيديو لطفل بعنوان «الطفل الفصيح ينتقد وزير التعليم»، انتقد الطفل خلاله الموضوعات التي يدرسونها في المدارس، مثل نص أدبي بعنوان «البخيل والدجاجة»، نطق الطفل عنوان النص باستخفاف ثم قرأه بلغة ركيكة، ليدلل أن مثل هذا الموضوع لا فائدة من دراسته، ثم وضح الموضوعات التي يجب أن تُدَرس بدلاً من ذلك، وهي برأيه موضوعات عن «العلوم» و «الشمس و «القمر».
اللافت في الأمر أن مثل هذا التوجه لرفض الأدب والفنون أو اعتبارها أمورًا غير جديرة بالدراسة، هو ضمن توجه عام يرى في العلم المادة الأهم للدراسة؛ فعند سؤال مجموعة من الأطفال ماذا يريدون أن يصيروا عندما يكبرون، تكون الإجابة في أغلبها: «طبيب أو مهندس»، يغذي هذا التوجه النظامُ التعليمي الذي يقسم الطلاب على أعتاب الثانوية إلى فئتين (علمي وأدبي)، إحداهما تدرس علومًا طبيعية صرفة والأخرى تدرس علومًا إنسانية صرفة، وبغض النظر عن عيوب النظام التعليمي عامةً، يبدو أن العلوم الطبيعية تحظى بالاهتمام الأكبر، يرى طلابها أنهم الأعلى درجة، وتُسمى كلياتهم «كليات القمة»؛ فهم حملة لواء العلم وجند الحضارة، حتى في مجال المنح التعليمية يكون الاتجاه الأكبر إلى التخصصات التي تدرس العلوم المادية، فما جذور هذا التوجه يا ترى؟ وما السبيل للوصول لفهم متوازن في هذا الجانب؟
جذور فكرية:
«يوجد عالمان: عالمٌ للآلة وعالم للموسيقى، هذان العالمان -حتى مع أقصى تحليل- لا يمكن إرجاعهما إلى أصل مشترك»(2)
فبينما يوجه العلم كل أنظاره للعالم المادي راغبًا في استغلاله وإخضاعه، معتمدًا على خطوات مدروسة، مُقيَّدًا بأرقام وقياسات لا يمكن تجاوزها، فإن الفن تعبير عن شعور الإنسان الداخلي وتفاعله مع الطبيعة، وهو في غالبه تعبير عن اغتراب الإنسان عن العالم، وقلقه الوجودي، فالفن إذًا غير هادف إلى غاية محددة، بعكس العلم المبني على أسباب ونتائج؛ فقصيدة أو لوحة فنية غير هادفة هي في نظر العلم مضيعة للوقت وإهدار للجهد، وهو الخلاف الجوهري بين العالم والفنان.
غير أن العلم لا يمكنه تحييد الفن، كما لن ينجح الفن إن حاول تهميش الحضارة متمثلة في العلم؛ لذا وجب الوصول إلى صلح فكري بين الفلسفتين، وأن تستوعب كل منهما الأخرى على أرضية من الوعي. فالعلم ليس هدفًا في حد ذاته بقدر ما هو وسيلة للتفاعل مع الطبيعة والإفادة منها، ولا ينبغي أن تطغي هذه الوسيلة -بأي حال- على مبتكرها (الإنسان) بروحه وعواطفه وعالمه المعنوي، وأن هذه الوسيلة (العلم) مهما وصلت في تقدمها وفهمها للعالم، فلن تحصل على صورة صحيحة ما دامت تهمل الإنسان، كما أن العلم وإن حاول إخضاع الإنسان لوسائله (كما في علم النفس وعلم الاجتماع) فإنه لن يسبر غور عالمه المجهول بتركيباته وتعقيداته، «فالتجربة الإنسانية المُعاشة هي توحيد بين الجانبين النظري والعملي، الروحي والمادي، ومن ثم فهذه التجربة المعاشة ليست هذا ولا ذاك، بل هي أكثر تركيبية من أي منهما بمفرده»(3)
فكل إنسان بذاته عالم خاص من الأسرار، والعالم المادي بدوره مليء بالقضايا المبهمة، ولنا أن نتخيل كم المجاهيل الناتجة عن تفاعل هذين العالمين الغامضين (في أغلبهما)،عبر عن هذه الرؤية المُربكة «ألبير كامو» حيث يقول: «أدرك أنني إذا كنت سأقبض على الظواهر وأحصيها بواسطة العلم، فإنني لا أستطيع -مع كل ذلك- أن أفهم العالم، ولو كنت سألمس كيانه كله بإصبعي فإني لن أعرف أكثر. غريب عن نفسي وغريب عن العالم، مسلح فقط بفكر ينفي نفسه في اللحظة التي ينطق فيها ببيان ما»(4)، ثم يعبر عن عبثية هذه العلوم الجادة التي مدت الإنسان بكم هائل من المعرفة، غير أنها معرفة تزيد حيرته ولا تروي ظمأه، عائدًا إلى إنسانيته المُهمَلة في عصر المنجزات الحضارية، فيقول: «إن الخطوط الناعمة لهذه التلال ويد السماء على هذا القلب القلق يعلماني أكثر. لقد عدت إلى بدايتي(5).
وأمام هذا التخبط البادي بين سعي للمعرفة والوضوح متمثلين في العلم، وإدراك الإنسان لزيف كل هذه المعرفة ما دام بعيدًا عن حقيقته، وغير مدرك لعلاقته الحقيقية بالعالم، يمكن الرجوع للفن كحل لهذه المُعضلة، فالمجاز هو الأداة التي يمكن من خلالها ربط المعلوم بالمجهول(6).
كانت الفلسفة محاولة جيدة لتعويض قصور العلم عن الوصول لفهم متكامل لهذه المتناقضات، فعنيت بالتساؤلات والفرضيات التي لا تجد إثباتات دقيقة، بحيث لا ترقى لتكون نظرية أو فرضية علمية(7)، واجتهد الفلاسفة باختلاف مشاربهم لتفسير متناقضات الإنسان وتفاعلاته مع الحياة، لكن الفلسفة -بإضافتها الناجعة- لم يكن لها أن تصل إلى تلك المنطقة المجهولة في روح الإنسان والتي يعبر عنها الفن وحده، متجاوزًا اللغة، عصيًا على الفكر والتنميط، عارضًا في كل قطعة فنية لونًا فريدًا مختلفًا عن غيره، منطبعًا بروح مُنتجه.
العلم المقدس:
«ما يحدث من العلمويين هو أنهم يحولون العلم إلى دين يلعب فيه العلماء دور القديسين الذين لا يجوز الانتقاص منهم، ويمسى العلم نفسه خلاصًا للإنسان، يعني من يمارس العلم ويؤمن به هو من يستحق النجاة والخلاص. يستخدم هؤلاء نفس اللغة الدينية عندما يقولون مثلًا: نحن نؤمن بالعلم رغم أن العلم نفسه ليس موضوعًا للإيمان وإنما للمعرفة والنقد..أسئلة من نوع: هل العالِم أفضل أو أنفع ام رجل الدين أسئلة فاشية في حد ذاتها، لا تختلف عن سؤال المتدين نفسه عن فائدة الفلسفة أو الفن؛ لأن كلًا منهما يريد أن يحظر بعض الأنشطة الإنسانية لصالح أنشطة أخرى.»
محمود هدهود
وصل العلم في سطوته إلى حد السيطرة على مفاصل الحياة، والتسلل إلى الفكر، محاولاً تنميط كل مظاهر الحياة الإنسانية، له في ذلك أتباعه المتعصبون، يحملون رايته مهاجمين كل من ينتهج غيره طريقًا أو يقلل من قدسيته؛ فالعلم -كما ذكرت- صار الهدف لا الوسيلة: قد يضحي الإنسان من أجله متخليًا عن حياته الاجتماعية، متناسيًا هواياته أو أنشطته المختلفة؛ سعيًا وراء التفوق الأكاديمي أو النتاج العلمي.
فانتشرت مجموعات «تبسيط العلوم» وكأنها في مهمة مقدسة للتبشير بهذا الدين، وصار العلماء البارزون كأنهم أنبياء العصر، لا يُنتقدون من حيث الفكر أو القيم أو الثقافة، ما داموا قد قدموا للعلم إنجازات، فهذا كفيل بأن يصيروا -في عرف العلم- معصومين.
ينظر الأطفال إلى عالم العلوم المادية المضاء اللذيذ بمصباح أديسون وتفاحة نيوتن خاصته منبهرين مفتونين، ويصير هو الهدف ويستصغر الصغار أي نشاط إنساني آخر بجانبه، وتتوارى خلف هذه المغريات الثقافة والقيم لحد يدفعنا للقلق من مستقبل تتضاءل فيه الإنسانية أمام الحضارة العلمية المادية. فهل من أبعاد أخرى للمسألة؟ وما السبيل لإنسانية متزنة؟.
إعداد: مريم ناصف
مراجعة وتحرير: آلاء مرزوق
تصميم: محمد الجوهري
المصادر:
(1) جبران خليل جبران. السابق. خاطرة عنوانها «العالم والشاعر».
(2) بيجوفيتش علي عزت. الإسلام بين الشرق والغرب. مؤسسة بافاريا للنشر والاعلام والخدمات, 1994.
(3) المسيري عبد الوهاب. رحابة الإنسانية والإيمان. دار الشروق, 2016
(4) Camus, Albert. “Le Mythe De Sisyphe.” 1942.
(5) المصدر السابق.
(6) عبد الوهاب المسيري. تقديم كتاب الإسلام بين الشرق والغرب. طبعة دار الشروق.
(7) “برتراند راسل : الفرق بين الفلسفة والعلم.” Www.youtube.com, 20 Apr. 2017, www.youtube.com/watch?v=pHi2s3xyYCw.