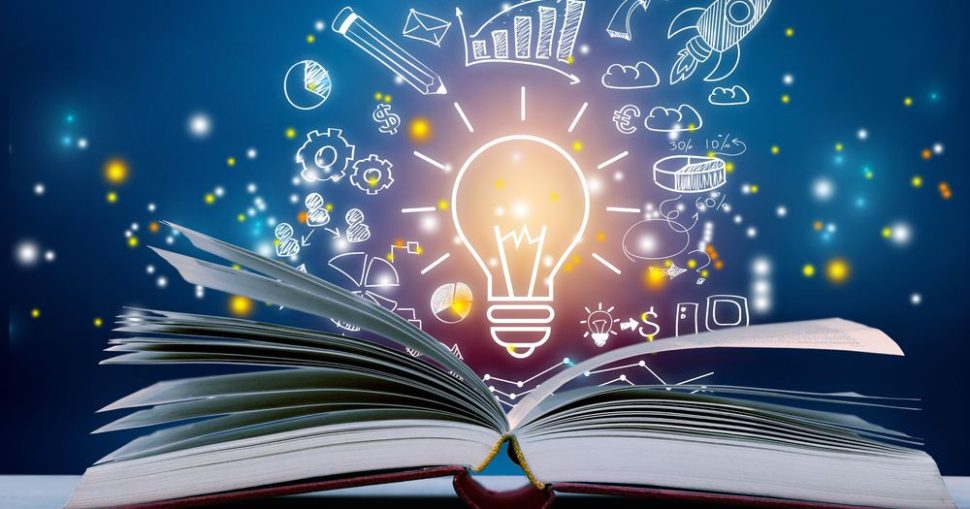لا أنسى حالة السخرية التي انتشرت بين أوساط العامة حين أرسلت وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) مركبةً إلى المريخ، تلك الحالة جعلتني أتذكر أنه في برنامجه الشهير — بل ربما الأشهر في القرن العشرين في تفسير القرآن — وحين أتى إلى تفسير قوله تعالى في سورة البقرة ﴿هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعًا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سموات وهو بكل شيء عليم﴾ جلس الشيخ الشعراوي أمام الكاميرا وقال مُعلِّقًا على صعود الأمريكان إلى القمر: «طب طلعنا القمر، استفدنا إيه؟ بالك اللي اكتشف المنديل بتاع الزكام دهوه، أحسن من اللي طلع القمر.»
أثارت هذه الكلمات غضب الدكتور زكي نجيب محمود وكتب في كتابه «أفكار ومواقف» يقول:
«فلقد كنت أستمع في التلفزيون إلى متحدثٍ جليل، فلما ورد في سياق حديثه محاولات العلماء الصعود إلى القمر وغير القمر من أجرام السماء، قال المتحدث الجليل أن منديل الورق الذي يمسح به أنفه المزكوم أنفع من صعود العلماء إلى القمر؛ فلو كان متحدثنا الجليل يعبِّر في ذلك عما يشعر به هو، وجعل السامعين على إدراك بأنه إذ يقول ذلك، فإنما هو ينظر إلى موضوع نظرة شاعر، لما كان في الأمر ما يُؤخذ عليه. وأمَّا أن يقول كلامًا كهذا في سياق عَرضٍ «علمي» لما يعرض له، فقد كان واجب «العقل» يقتضيه أن يتقصَّى الحقائق في موضوعية العلماء. ولو فعل ذلك لعرف أن إحدى النتائج الفرعية الجانبية التي نَتجَت لنا عن الصعود إلى القمر، تلك الأقمار الصناعية التي نستخدم بعضها في نقل البث التلفزيوني إلى أرجاء العالم كله في لحظةٍ واحدة. ومن يدري؟ فلعل محدثنا الجليل كان في حديثه ذاك مسموعًا للعالم الإسلامي كله بواسطة أقمارٍ صناعية، جاءت نتيجةً فرعيةً لمحاولات الصعود إلى القمر، التي قال عنها سيادته إن ورقة يمسح بها أنفه المزكوم أنفع منها.»
ما أكثر ما يتكرر هذا السؤال الذي سأله الشيخ الشعراوي في حديثه: ما الذي عاد على البشرية من صعود الإنسان إلى القمر؟ وماذا جنينا من دراسة الثقوب السوداء التي تقع في ظلمات الكون السحيق؟ وأي نفعٍ يأتينا من تلك المليارات التي تُبذل في مجال الفيزياء النظرية، والتي لا تُشبِع جائعًا ولا تُروي عطشانًا؟ أليس الأجدر أن تُستثمر تلك الثروات الهائلة التي تُنفق في أبحاث الفلك والنجوم لخدمة قضايا ملحة، كإطعام الجياع، وعلاج المرضى، وتخفيف معاناة البشرية؟ وعندها تبدأ الإجابة المُعتادة كما ذكرها الدكتور زكي نجيب محمود ردًا على الشيخ الشعراوي، وقال: إن التليفزيون الذي يراك الناس عن طريقه هو نتيجة غير مباشرة من نتائج صعود الإنسان إلى القمر. أو يقول غيره: إن نظام الملاحة (GPS) الذي يسير الناس على هُداه لم يكن ليُخترع لولا نظرية أينشتاين التي أطلّت في زمانها على البشر وكأنها سرابٌ بعيد، لا يمسّ حياتهم بشكلٍ مباشر.
وهكذا، نجد أن العلماء — في مواجهتهم لهذا الطرح المحدود — وكأنهم مجبرون على تبني أسلوب الدفاع، محاولين طمأنة المجتمع بأن العلم سيُثمر، وإن لم يكن اليوم فغدًا، وكأن عليهم إقناع الآخرين بأن المعرفة إن لم تُقدّم لهم منافع ملموسة فورًا، فإنها مع مرور الزمن ستفعل. يبيت العلماء تحت ضغط الاعتذار، يبررون ويعللون، ويُقدّمون وعودًا مستقبلية تُشير إلى أن ما يبدو اليوم محض تجريد ونظرية، قد يُصبح غدًا حاجةً أساسية، كما حدث مع بعض العلوم والنظريات التي ظلت سنوات طويلة بلا قيمة ملموسة، ثم حملت للبشرية خيرًا وفيرًا.
وفي خضم هذا التبرير المتكرر، يتراجع العلماء عن جوهر رسالتهم، ليَظهروا وكأنهم في حاجة إلى إرضاء القائلين بأن العلم لا يستحق مكانه إلا بما يُقدّمه من فائدة مادية آنية. يغدو العلم في نظر العامة — بل والعلماء — شيئًا يُساوَم على جدواه، وهم لا يرونه إلا في حدوده الضيقة، ولا يشعرون بقداسته كنافذة على عالم أوسع وأعظم. وكأنما على العلماء تبرير كل رحلة استكشاف أو كل معادلة معقدة بتطبيق عملي قريب، فإن لم يوجد تطبيق عملي قريب، يعدون الناس بتطبيق عملي بعيد، دون أن يدرك كلٌ من العلماء قبل العامة أن العلم بذاته احتفاء بالوجود، وحاجة إنسانية لإشباع ذلك الشغف الأزلي تجاه المجهول، ورغبة حقيقية في المعرفة التي لا تقف عند حدود المنفعة.
لا يُحتَّم على العلماء، بل لا ينبغي لهم، أن يكونوا تجار فوائد، ولا أن يتحدثوا بلسان الحاجة والضرورة المادية؛ فالتفكير العلمي يُنير العقول قبل أن ينفع الجيوب، ويسهم في بناء الوعي والفهم العميق قبل أن يُحسّن سُبل المعيشة. إن العلم، بنقائه وأهدافه السامية، يحرّر الإنسان من قيود الجهل، ويمده بأدوات للتحرر من الظلمات، ويمنحه سلاحًا ضد الخرافة. بل إنه يُعلّمه أن الحياة ليست مجرد رحلة استهلاك، وأنها أكبر من مجرد حسابات نفعية، بل هي أفق واسع من الأفكار والاكتشافات التي تتيح لنا فهم الجمال والعظمة في الكون.
العلم الحقيقي لا يتطلب من حامليه أن يقدموا الوعود، ولا أن يُضطروا إلى الدفاع عن قيمته، بل يكمن في عظمة أسئلته وقدرته على فتح آفاقٍ جديدة للتفكير والتأمل، ليرتقي بالإنسان إلى مستوى الإدراك العميق لنفسه وللكون من حوله، ويعلّمه أن بعض الأشياء — على نُبلها وسموها — لا تحتاج إلى تبرير مادي، فهي بذاتها غاية وفضيلة.
وهكذا، نجد العلماء، بتبنيهم أسلوب التبرير الدفاعي هذا، يسهمون، ولو بغير قصد، في خفض قيمة العلم وجعلها رهينة لمعاييرٍ مادية بحتة، وكأنهم بذلك ينزلون على رأي من يجهلون جوهر العلم وعمقه. بدلًا من تغيير نظرة المجتمع تجاه العلم وإعلاء قيمته، يرضخ العلماء لهذه المطالب، متناسين أن دورهم الأسمى أن يرفعوا الناس من قاع الجهل إلى قمم الفهم والمعرفة، لا أن ينزلوا هم إلى الأسفل إرضاءً لرغبات من لا يدرك قيمة العلم وفضله.
حينما يتبنى العلماء موقف التبرير بوعود مستقبلية، يقبلون ضمنيًا بنظرةٍ ضيقة تُقصر العلم على ما يعود بفائدة مادية سريعة، وبذلك يُفرّطون في رسالته الحقيقية؛ فيصبح العلم، تحت ضغط هذه النظرة القاصرة، كأنه عَرَض زائلٌ ينتظر التبرير، لا جوهر سامٍ يكتفي بذاته. إن الانصياع لهذه الرؤية المجتزأة للعلم يُعدّ تراجعًا عن الدور التنويري الذي يلتزم به العلماء، ويضعهم في موقع المدافع بدلًا من موقع المرشد الذي يسعى لرفع الوعي، وتقديم العلم كمسعى نبيل يهدف إلى الارتقاء بالإنسانية.
فليسامحني الدكتور زكي نجيب محمود لأني أرى أجابتَه غير مُوفّقة حين أجاب على الشيخ الشعراوي وقال استفدنا أقمارًا صناعية تنقل لقاء الشيخ الشعراوي للناس، فقد وقع في الفخ وسلّم له أن العلم النافع هو العلم الذي ينتج لنا أجهزةً جديدة، وكان عليه إعادة تغيير المفهوم ليقول: إن تعريفكم ونظرتكم للعلم نظرة أناس ماتت قيمةُ العلم في نفوسِهم، بل ماتت نفوسُهم وذبلت. كان عليه أن يجيب: استفدنا نورًا من علم الله، ومحونا ظلامًا من الجهل، استفدنا معرفةً أمرنا الله بها، وإعمالًا لعقولنا التي حضنا الله على استخدامها والتفكير بها، استفدنا إخراج إنسان يسأل ويعلم ويفكر ويتأمل ويصل، إنسان يتفكر في ملكوت السماوات والأرض، إنسان سأل ربه أن يزيده من العلم فزاده. أما فضيلتكم، فتريدون ظلامًا وجهلًا، تريدون انتكاسةً لروح البشر وصفاتهم، فإذا قال الله أنه يرفع الذين أوتوا العلم، فأنتم تريدون أن تحطوا من العلم وأهله. وشتان بين عقلٍ ينادي أن يرتفع بالعلم — أي علم — وعقلٍ آخر يريد أن ينحطّ بالجهل.
ألا مَن يُبَلِّغْ عن السيد المسيح قولَه بأن «ليس بالخبز وحده يحيا الإنسان» [إنجيل متى ٤:٤]، بل يحيا الإنسان — إلى جانب الخبز — بالعلم، والفهم، والحكمة، فهذه هي مطايا العظماء، وزادُ السالكين، ومقصدُ الراقين في مدارج الفضل.
وإننا لَنأبى أن نكون كمَن اختار الظلمةَ على النور، وقنع من الحياةِ الدنيا واطمئن بها بما يُرضي جسده وبطنَه، ونسى أن له روحًا تتعطش للعلم، وتشتاق للمعرفة، لا لشيءٍ إلا لأنها معرفة وفقط.
إن استنكاف الناس عن بذل المال والجهد في العلوم التي يرونها «غير نافعة» ولا تدر عليهم عائدًا ماديًا مباشرًا أو غير مباشر، ليس أمرًا جديدًا، كما أن استهجان الشيخ الشعراوي وغيره لهذا النوع من العلوم لم يكن بالأمر المبتدع. فهاتان الطائفتان من البشر – أقصد تلك التي تسعى للارتقاء بالعلم لذاته دون التفات إلى مردوده المادي، والأخرى التي لا ترى قيمةً إلا في المنفعة الحسية والمكاسب الدنيوية – قد وُجدتا منذ أن خلق الله الأرض ومن عليها.
وإن كان هؤلاء، أمثال الشيخ الشعراوي أو المعترضين على تمويل مشاريع علمية كأموال وكالة «ناسا»، ما زالوا يعيدون هذه الاعتراضات ويرددون هذه القيم المادية، فإن ذلك يعيدنا إلى نموذج قديم يصل إلى ٢٧٠٠ سنة مضت، أشار إليه أرسطو في كتابه «السياسة»، حيث ذكر قصة فيلسوف سبقه، طاليس، الذي يُعد أول الفلاسفة المعروفين في التاريخ.
كان طاليس فقيرًا مُعدمًا، وقد سخرت منه العامة واتهموه بإضاعة وقته في الفلسفة وعلم الفلك دون أن يجلب لنفسه نفعًا ماديًا. إلا أن طاليس، بأعمال عقله وفطنته، توقع زيادة إنتاج الزيتون في إحدى السنوات. فاستأجر جميع معاصر الزيتون في مدينته خلال فصل الشتاء، أي قبل موسم الحصاد. وعندما حان الوقت واحتاج الناس إلى تلك المعاصر، لم يجدوا بدًّا من التعامل معه وفق شروطه وأسعاره. وهكذا، حقق طاليس ثروة كبيرة في وقت قصير.
لكن هدف طاليس لم يكن السعي وراء المال أو الثراء، بل أراد – كما أوضح أرسطو – أن يثبت للناس أن الفلاسفة قادرون على جمع الثروة متى شاءوا، ولكنهم يترفعون عنها لأن غايتهم الأسمى هي البحث عن المعرفة، والارتقاء بها، لا اللهاث وراء المال أو المكاسب الحسية.
فهذه القصة، إذ تُروى عبر التاريخ، تعكس بجلاء ذلك الجدل الأزلي بين من يسعى إلى العلم لغاية سامية، ومن لا يرى فيه إلا وسيلةً لتحقيق منفعة مادية.[1]
هذا ما أردت أن أقوله وأكتبه، لكن الإضافة التي أردت أن أضيفها في هذا المقال هو ترجمة لمقال عظيم كتبه أبراهام فلكسنر، هذا الرجل الذي أسس معهد الدراسات المتقدمة، واستقطب في تلك الجامعة أبرز وألمع العقول على الإطلاق، وقبل أن أبدأ في ترجمة هذا المقال أريد أن أعطي لمحةً عن هذا الرجل، وعن ذلك المعهد، وعن المقال الذي اخترت نقله إلى اللغة العربية.
******
سيرة أبراهام فلكسنر (Abraham Flexner)
وُلد أبراهام فلكسنر في 13 نوفمبر 1866 في مدينة لويفيل بولاية كنتاكي، لعائلة يهودية مهاجرة من ألمانيا. كان السادس من بين تسعة أطفال. عائلته كانت متواضعة الحال، لكنه برع أكاديميًا منذ صغره، مما جعله يتميز عن أقرانه.
- حصل على درجة البكالوريوس من جامعة جونز هوبكنز، إحدى أولى الجامعات البحثية في الولايات المتحدة.
- بدأ حياته المهنية كمعلم ثم افتتح مدرسة تجريبية في لويفيل عام 1890، حيث ركّز على أساليب تعليمية مبتكرة تعتمد على التفكير النقدي بدلاً من الحفظ والتلقين.
انطلق فلكسنر في حياته المهنية كمصلح تعليمي مع نشر تقريره الشهير “تقرير فلكسنر” في عام 1910، الذي كان بتكليف من مؤسسة كارنيغي. ركز التقرير على إصلاح التعليم الطبي في الولايات المتحدة وكندا، حيث كشف عن ضعف المناهج الدراسية وسوء البنية التحتية للعديد من المدارس الطبية آنذاك.
- أدى إلى إغلاق أو دمج العديد من الكليات الطبية غير المؤهلة.
- رسّخ معايير أكاديمية أعلى، تتضمن التدريب السريري والتعليم القائم على البحث.
- أسس لنظام التعليم الطبي الحديث في أمريكا الشمالية، والذي يركز على البحوث التطبيقية والتطبيق العملي.
في عام 1930، أسس فلكسنر معهد الدراسات المتقدمة (Institute for Advanced Study) في برينستون، نيوجيرسي، بتمويل من عائلة بوكر (Louis Bamberger and Caroline Bamberger Fuld). هدف المعهد إلى توفير بيئة بحثية حرة بعيدًا عن الضغوط الأكاديمية أو الاقتصادية.
- أن يكون مركزًا للبحث النقي، غير المرتبط بالقيود العملية أو السياسية.
- جذب ألمع العقول من مختلف أنحاء العالم للتعاون في أجواء من الحرية الفكرية.
- كان المدير المؤسس للمعهد، حيث شجّع على التداخل بين التخصصات وجذب كبار العلماء.
- من أشهر الباحثين الذين عملوا في المعهد خلال فترة إدارته: ألبرت أينشتاين، الذي انضم للمعهد في عام 1933 بعد هروبه من ألمانيا النازية.
- أُعتبر المعهد نموذجًا عالميًا للمؤسسات الأكاديمية البحثية، إذ ركّز على المعرفة من أجل المعرفة، وليس فقط لتحقيق مكاسب اقتصادية أو تكنولوجية فورية.
- كان له دور رئيسي في دفع حدود الفيزياء النظرية والرياضيات والعلوم الاجتماعية.
فلسفته في التعليم والبحث
فلكسنر كان يؤمن بشدة أن الفضول البشري يجب أن يكون القوة الدافعة للتعليم والبحث، وليس فقط الحاجات العملية أو الاقتصادية. عبّر عن هذه الفلسفة في مقاله الشهير “The Usefulness of Useless Knowledge” (1939)، حيث أوضح أن البحث الأساسي، حتى لو بدا بلا فائدة، غالبًا ما يؤدي إلى أعظم الاكتشافات التي تغير العالم.
معهد الدراسات المتقدمة (Institute for Advanced Study)
تأسيس المعهد
أُسس المعهد عام 1930 كأول مؤسسة مستقلة للبحث العلمي الخالص في الولايات المتحدة. كان الهدف الأساسي هو توفير بيئة بحثية حرة وخلاقة للعلماء، بعيدًا عن القيود البيروقراطية وضغوط التدريس.
الفكرة الفلسفية وراء المعهد
- حرية البحث: يتم تشجيع العلماء على العمل في موضوعات تهمهم دون الاهتمام بنتائج فورية أو توقعات.
- التعددية الفكرية: يضم المعهد تخصصات متعددة مثل الرياضيات، الفيزياء النظرية، العلوم الاجتماعية، والإنسانيات.
- جذب أفضل العقول: قام بجذب علماء عالميين مثل أينشتاين، كورت غودل (المنطقي المعروف)، وجون فون نيومان (رائد الحوسبة الحديثة).
إنجازات المعهد
- أصبح مقرًا لبعض أهم الأبحاث العلمية في القرن العشرين.
- لعب دورًا رئيسيًا في تطوير الفيزياء الحديثة، وخاصة في مجال ميكانيكا الكم والنسبية.
- دعم النظريات الأساسية التي أدت إلى تطوير الكمبيوتر، علم الذكاء الاصطناعي، وأبحاث الكونيات.
مقال “The Usefulness of Useless Knowledge”
السياق التاريخي والفكري
كُتب هذا المقال في وقت كان العالم فيه منشغلًا بالتطبيقات الفورية للعلوم، خاصة خلال فترة الكساد الكبير والتهيئة للحرب العالمية الثانية. أراد فلكسنر تقديم دفاع قوي عن أهمية البحث العلمي الذي لا يتبع احتياجات السوق أو السياسات.
الفكرة الرئيسية
يشير فلكسنر إلى أن العديد من أعظم الإنجازات البشرية جاءت نتيجة البحث الذي لم يكن يهدف إلى تحقيق منفعة عملية فورية. على سبيل المثال:
- الفيزياء النظرية التي ساعدت في تطوير الطاقة النووية.
- الأبحاث الرياضية البحتة التي أصبحت أساسًا للذكاء الاصطناعي.
تأثير المقال
- ألهم العلماء والمؤسسات لتقدير قيمة البحث النقي.
- أصبح المقال مرجعًا فلسفيًا في النقاشات حول تمويل الأبحاث ودورها في المجتمع.
“النص المترجم”
أليس من المدهش أننا، في عالم تكتنفه الكراهية العمياء والعبثية التي تهدد أسس الحضارة نفسها، نجد رجالًا ونساءً، كبارًا وصغارًا، ينسحبون من صخب الحياة اليومية وضجيجها؟ هؤلاء يكرّسون أنفسهم، كليًا أو جزئيًا، لزرع الجمال، ونشر المعرفة، ومداواة الجراح، وتخفيف معاناة البشر، كأنهم يتجاهلون وجود أولئك المتعصبين الذين يُمعنون، في الوقت ذاته، في نشر القبح والألم والمعاناة. لقد ظل العالم دائمًا مرتعًا للفوضى والحزن، ومع ذلك، نرى الشعراء والفنانين والعلماء يتحدّون هذا الواقع الذي، لو استسلموا له، لثنّاهم عن مساعيهم الجليلة.
من منظور عملي، قد تبدو الحياة الفكرية والروحية في ظاهرها نوعًا من الترف، ينغمس فيها الناس لما تمنحه من لذة ورضًا أعمق مما تقدمه الخيارات المادية. ولكن في هذا المقال، سأناقش إلى أي مدى يمكن لهذه المتع “غير النافعة” أن تصبح مصدرًا لفوائد عظيمة وغير متوقعة.
كثيرًا ما يُقال، بإلحاح بات يبعث على الملل، إن عصرنا هذا مادي بطبيعته، يسعى لتحقيق استفادة أوسع من الموارد وإتاحة فرص دنيوية متكافئة للجميع. وقد دفعت الدعوات المشروعة لتحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية أجيالًا من الطلاب إلى التوجه نحو دراسات تهتم بهذه القضايا بدلاً من المجالات التقليدية التي شغلت آباءهم. وعلى الرغم من أنني لا أعترض على هذا التوجه، بل أدعمه، فإنني أجد نفسي أحيانًا أتساءل: هل أصبح هذا التيار قويًا إلى حد يُقصينا عن حياة متكاملة؟ وهل هناك مساحة كافية للأشياء التي تبدو “غير نافعة”، لكنها تمنح العالم قيمته الروحية؟
بعبارة أخرى: هل ضاقت رؤيتنا لما هو “نافع” حتى باتت تعجز عن استيعاب الإمكانات الشاسعة للروح الإنسانية؟
يمكننا مقاربة هذه القضية من زاويتين: الأولى علمية، والثانية إنسانية وروحية. وأود أن أبدأ بالزاوية العلمية. أستعيد هنا ذكرى حوار دار بيني وبين السيد جورج إيستمان (George Eastman) قبل سنوات. كان رجلًا يجمع بين الحكمة ورقة الطبع، وذوقًا رفيعًا في الموسيقى والفنون. خلال حديثنا، أعرب عن نيته تخصيص ثروته لتطوير التعليم في المجالات “المفيدة”. فاغتنمت الفرصة لسؤاله عن رأيه حول العالِم الذي قدّم أعظم إسهام للبشرية. دون تردد، أجاب: “غولييلمو ماركوني، ذاك العالم الإيطالي الذي اخترع الراديو”.
أبديت اندهاشي وقلت له: “مع كل ما أضفاه الراديو والاتصالات اللاسلكية من متعة وفائدة، فإن إسهام ماركوني، مقارنة بما يظن البعض، قد يكون محدودًا.”
كان واضحًا أن كلامي أثار دهشته، فطلب مني توضيح فكرتي. وها أنا أستعيد تلك اللحظة لأوضحها مجددًا، فقلت له:
عزيزي السيد إيستمان، إن ماركوني لم يكن سوى ثمرة حتمية لمسار التطور العلمي الذي سبق مجيئه بسنوات. أما الفضل الحقيقي لكل الإنجازات التي تحققت في مجال الاتصالات اللاسلكية، فإنما يعود – بقدر ما يمكن إرجاع الفضل لشخص معين – إلى البروفيسور جيمس كليرك ماكسويل. فقد أجرى ماكسويل في عام 1865 حسابات دقيقة ومعقدة في مجالي الكهرباء والمغناطيسية، وصاغها في معادلات رياضية مجردة نشرها في أطروحته الشهيرة عام 1873.
بعد ذلك بفترة وجيزة، وخلال اجتماع الجمعية البريطانية، أعلن البروفيسور سميث (H.J.S. Smith) من جامعة أكسفورد قائلاً: “لا يمكن لأي عالم رياضيات أن يقرأ هذه الأطروحات دون أن يدرك أنها تتضمن نظرية أحدثت تطورًا عظيمًا في علم الرياضيات البحتة.” وعلى مدى خمسة عشر عامًا تلت نشر تلك الأطروحات، جاءت اكتشافات علمية أخرى لتُكمل البناء النظري الذي وضعه ماكسويل. وفي عامي 1887 و1888، تمكن العالم الألماني هاينريش هيرتز (Heinrich Hertz)، أثناء عمله في مختبر هلمهولتز في برلين، من إثبات وجود الأمواج الكهرومغناطيسية، وحل اللغز العلمي المتبقي في هذا المجال، وهو الكشف عن الناقل الأساسي للإشارات اللاسلكية.
اللافت في الأمر أن لا ماكسويل ولا هيرتز كانا معنيين بأي تطبيق عملي لعملهما؛ مثل هذه الأفكار لم تخطر ببال أي منهما. لم يكن لهما هدف سوى التعمق في فهم الطبيعة واكتشاف أسرارها. أما ماركوني، الذي نُسبت إليه الشهرة كـ “مخترع”، فقد كان دوره أقرب إلى من وضع اللمسات الأخيرة، مثل جهاز استقبال بسيط يُدعى “الكوهيرر”، والذي أصبح اليوم مهملًا وتقادم استخدامه.
ماكسويل وهيرتز لم يقدما اختراعًا ملموسًا، لكن أعمالهما النظرية، التي صنّفها البعض ضمن العلم “الذي لا ينفع”، كانت الأساس الذي استند إليه تقنيٌ مُبدع لتحويل تلك الأفكار إلى أدوات أحدثت ثورةً في عالم الاتصال والترفيه. وهكذا، نال من قام بالتطبيق العملي شهرة واسعة وثروات طائلة، بينما ظلت أسماء العباقرة الحقيقيين، مثل ماكسويل وهيرتز، أقل شهرة. ومع ذلك، إذا أردنا الحديث عن الفائدة الحقيقية للبشرية، فإنها تعود دون شك إلى هؤلاء الذين لم يكن في أذهانهم سوى شغفهم بالعلم.
وحين ذُكر اسم هيرتز، استعدت ذكرى الأمواج الهيرتزية، ونصحت السيد إيستمان بالتوجه إلى الفيزيائيين في جامعة روتشستر ليتعرفوا على عظمة الإنجازات التي حققها كل من هيرتز وماكسويل. مع ذلك، أكدت له حقيقة جوهرية: أن التاريخ العلمي بأكمله يُظهر أن أعظم الاكتشافات التي غيرت مسار الإنسانية كانت نتاج شغف وفضول معرفي خالص، وليس رغبة في تحقيق منفعة مباشرة.
“الفضول والشغف؟” تساءل السيد إيستمان بدهشة.
“نعم”، أجبته، “إن الفضول، تلك الشرارة التي قد تقودنا إلى اكتشافات عظيمة أحيانًا، أو إلى نتائج لا تحمل أي تطبيق عملي في أحيان أخرى، يُعدّ السمة الأبرز للفكر الإنساني في عصرنا الحديث. لكنه ليس سمةً جديدة؛ إذ تمتد جذورُه إلى عصور غاليليو، وفرانسيس بيكون، والسير إسحاق نيوتن. هذا الفضول، بطبيعته الحرة وغير المقيدة، هو ما يجب أن يكون في صلب أهداف مؤسساتنا التعليمية. فكلما تجنبت هذه المؤسسات الانزلاق نحو التركيز على التطبيقات المباشرة والمادية، زادت قدرتها على الإسهام في رفاهية البشرية، وتحقيق الإشباع الفكري العميق الذي أصبح بمثابة الشغف الأعظم للفكر الإنساني الحديث.”
******
ما يمكن أن يُقال عن هاينريش هيرتز، الذي عمل بصمتٍ في زاوية متواضعة من مختبر هلمهولتز (Helmholtz’s laboratory) في أواخر القرن التاسع عشر، ينطبق أيضًا على العلماء والرياضيين في مختلف بقاع العالم وعلى مدى قرون طويلة مضت. نحن اليوم نعيش في عالم قائم على الكهرباء، تلك القوة التي أصبحت جوهر حياتنا الحديثة. وإذا طُلب منا تحديد الاكتشاف الذي ترك الأثر الأعمق على العالم، فإن الإجابة ستكون بلا شك: الكهرباء. لكن السؤال الأهم يظل: من هم أولئك الذين قدّموا الاكتشافات الجوهرية التي أطلقت شرارة هذا التقدم الكهربائي الهائل؟
الإجابة تحكي قصة إلهام وشغف. مايكل فاراداي (Michael Faraday)، ابن الحداد البسيط، بدأ حياته المهنية كمتدرب في تجليد الكتب. في عام 1812، وهو في الحادية والعشرين من عمره، اصطحبه صديق إلى المؤسسة الملكية لحضور سلسلة محاضرات ألقاها السير همفري ديفي (Humphry Davy) حول الكيمياء. لم يكتف فاراداي بالحضور، بل دوّن ملاحظات دقيقة وأرسلها إلى ديفي، مما لفت انتباه هذا العالم البارز. وفي العام التالي، عُيّن فاراداي مساعدًا لديفي في مختبره، حيث بدأ رحلته العلمية. وبعد عامين، انطلق معه في رحلة علمية إلى القارة الأوروبية، زادت من توسيع آفاقه.
بحلول عام 1825، تولى فاراداي منصب مدير مختبر المؤسسة الملكية، وظل يشغل هذا المنصب بتفانٍ وإبداع لأكثر من نصف قرن، تاركًا بصمة خالدة في تاريخ العلم. في البداية، انصبّ تركيزه على الكيمياء، لكنه سرعان ما تحول نحو الكهرباء والمغناطيسية. كان هذا المجال مليئًا بالألغاز التي حاول الكثير من العلماء الإجابة عنها، أمثال أورستد وأمبير وولاستون. هنا بزغ نجم فاراداي، الذي أزاح الكثير من الغموض. ففي عام 1841، اكتشف الحث الكهربائي، وبعد ذلك بأربع سنوات، كشف تأثير المغناطيسية على الضوء المستقطب.
إن اكتشافاته الأولى، مثل الحث الكهربائي، كانت حجر الزاوية للعديد من التطبيقات العملية التي جعلت من الكهرباء قوة هائلة أسهمت في تحسين حياة البشر. أما اكتشافاته اللاحقة، التي لم تكن بنفس الأثر العملي، فقد جاءت مدفوعة بشغف فكري خالص. بالنسبة لفاراداي، لم يكن دافع العمل هو المنفعة أو الربح؛ بل كان الفضول هو المحرك الذي قاده لحل ألغاز الكون، بدايةً من الكيمياء وصولًا إلى الفيزياء.
لم يكن الفضول بالنسبة لفاراداي مجرد صفة شخصية، بل كان نهجًا في الحياة. لم تُقيده فكرة الفائدة المباشرة، ولم يكن ليتردد لحظة في متابعة تساؤلاته العلمية مهما بدت بعيدة عن الواقع العملي. في النهاية، أثمرت تجاربه عن فوائد عظيمة للبشرية، لكن تلك المنافع والفوائد والتطبيقات العملية لم تكن يومًا هدفه. لقد كان الفضول، بشغفه وإصراره، هو القوة التي قادت فاراداي ووجهت خطاه.
في عصرنا الحالي، من المهم أن ندرك حقيقة أن مساهمة العلم في جعل الحروب أكثر تدميرًا وبشاعة كانت نتيجة عرضية وغير مقصودة للنشاط العلمي. فقد أشار اللورد رايلي (Lord Rayleigh)، رئيس الجمعية البريطانية لتقدم العلوم، في خطاب حديث، إلى أن المسؤولية الحقيقية عن الاستخدام المدمر للنتائج العلمية تقع على عاتق حماقة الإنسان، لا على نوايا العلماء وإرادتهم.
لقد كان البحث العلمي في كيمياء مركبات الكربون، الذي أثمر فوائد عظيمة للبشرية، مثالًا حيًا على هذه المفارقة. فقد أدى إلى اكتشاف التفاعلات بين حمض النيتريك ومركبات مثل البنزين والجلسرين والسليلوز، مما أسفر عن إنتاج صبغات الأنيلين المفيدة. لكن هذا البحث ذاته كشف عن مادة النيتروجليسرين، التي امتزجت فيها الاستخدامات البنَّاءة بالمُدمِّرة.
وفي وقت لاحق، أظهر ألفريد نوبل أن خلط النيتروجليسرين مع مواد أخرى يمكن أن يُنتج مادةَ الديناميت، وهي مادة متفجرة أكثر أمانًا عند التعامل معها. لعب الديناميت دورًا محوريًا في التقدم التكنولوجي، حيث ساهم في شق الأنفاق، وبناء السكك الحديدية، وتسهيل التعدين في المناطق الجبلية. ومع ذلك، لم يسلم هذا الإنجاز العلمي من سوء الاستخدام، إذ استُغل في أعمال الحرب والدمار على أيدي السياسيين والعسكريين.
لكن هل يمكن إلقاء اللوم على العلماء في هذا؟ بالطبع لا. فالعلماء ليسوا أكثر مسؤولية عن ذلك من مسؤوليتهم عن الزلازل أو الفيضانات. الغازات السامة، على سبيل المثال، تُظهر كيف يمكن أن يُستخدم العلم لخدمة البشرية أو لإيذائها، بناءً على نوايا البشر. حتى تاريخيًا، قضى العالِم الروماني بلينيوس الأكبر (Pliny) نحبه بعد استنشاق ثاني أكسيد الكبريت خلال ثوران بركان (فيزوف) قبل ألفي عام. ولم يكن العلماء حينها قد عزلوا الكلور أو ابتكروا غاز الخردل. هذه المواد في أصلها كانت أدوات علمية محايدة، يمكن أن تُسخر لفائدة البشر أو ضدهم.
وعندما بلغت الطائرةُ مرحلةَ الكمال كاختراعٍ رائع يفتح آفاق السماء، ظهرت عقولٌ مريضة وقلوب ملأها الحقد لتحوّل هذا الابتكار البريء إلى أداة للدمار الشامل. هذا الاستخدام الشنيع لم يكن يومًا في نوايا المخترعين، ولم يكن نتاج سنوات الجهد العلمي المخلص.
حتى في مجال الرياضيات البحتة، نجد أمثلة بارزة على كيفية تطور الأفكار العلمية البحتة إلى تطبيقات عملية عظيمة. “الهندسة غير الإقليدية”، التي أحدثت ثورة في القرن الثامن عشر والتاسع عشر، كانت ثمرة عبقرية كارل فريدريش جاوس، أحد أعظم علماء الرياضيات. ومع ذلك، لم يجرؤ جاوس على نشر أفكاره حولها لمدة ربع قرن. كانت هذه الهندسة هي الأساس الذي بنيت عليه نظرية النسبية لأينشتاين، بما تحمله من تطبيقات غير مسبوقة.
وبالمثل، ظهرت “نظرية المجموعات” كنظرية رياضية مجردة لا تطبيق عملي لها، وكانت نتاج شغف العلماء بالمعرفة. لكنها أصبحت فيما بعد حجر الزاوية لنظرية الكم، وتُستخدم اليوم على نطاق واسع في مجالات لا يدرك مستخدموها غالبًا جذورها الفكرية.
أما حساب الاحتمالات، فقد وُلد من محاولات رياضيين لفهم المقامرة وإضفاء طابع عقلاني عليها. ورغم فشلهم في تحقيق هدفهم الأولي، أصبحت هذه النظرية لاحقًا أساسًا للتأمين الحديث، وأحد الركائز الكبرى للإنجازات الفيزيائية في القرن التاسع عشر.
هذه الأمثلة توضح كيف يتحول الفضول العلمي المجرد، الذي يبدو أحيانًا بعيدًا عن الواقع، إلى قوة دافعة تُطلق البشرية نحو آفاق جديدة وغير متوقعة، تحمل معها الخير أو الشر بحسب اختيار الإنسان.
بلغت عبقرية البروفيسور ألبرت أينشتاين أوجها حين أُميط اللثام عن حقيقة مدهشة: فقد صاغ هذا الفيزيائي الرياضي الفذ، قبل خمسة عشر عامًا، معادلات رياضية ساهمت في فك لغز علمي عظيم يتعلق بالسيولة الاستثنائية لعنصر الهيليوم عند اقتراب درجة حرارته من الصفر المطلق.
في ندوة نظمتها الجمعية الكيميائية الأمريكية حول التفاعلات الجزيئية، أشار البروفيسور فريتز لندن (Fritz London)، من جامعة باريس، والذي يشغل حاليًا منصب أستاذ زائر في جامعة ديوك، إلى أن الفضل في مفهوم “الغاز المثالي” يعود لأينشتاين، استنادًا إلى أوراق بحثية نشرها بين عامي 1924 و1925.
لم تتناول هذه الأبحاث الشهيرة نظرية النسبية، بل تعمقت في مسائل بدت حينها مجردةً وبعيدةً عن التطبيق العملي. فقد ناقش أينشتاين خصائص “الغاز المثالي” عند درجات الحرارة المنخفضة للغاية، إلا أن العلماء آنذاك، الذين كانوا يدركون أن الغازات تتكثف لتصبح سوائل في مثل هذه الظروف، لم يولوا اهتمامًا يُذكر لعمله. وهكذا، ظل هذا الإسهام العلمي طي النسيان لفترة طويلة.
لكن اكتشافًا حديثًا قلب الموازين، مذكرًا العالَمَ بأن الأفكار التي تبدو بلا جدوى في لحظتها قد تحمل بين طياتها حلولًا عظيمة لألغاز المستقبل. فقد كشف السلوك العجيب للهيليوم السائل عن أبعاد جديدة غير متوقعة لأفكار أينشتاين التي كانت مهملة. بخلاف السوائل التقليدية التي تزداد لزوجتها مع انخفاض درجات الحرارة، يتسم الهيليوم السائل بخصائص فريدة تتحدى هذه القاعدة. على سبيل المثال، عند درجة حرارة تُعرف بنقطة “دلتا” (2.19 درجة فوق الصفر المطلق)، يُظهر الهيليوم تدفقًا استثنائيًا يفوق تدفقه عند درجات حرارة أعلى، ليبدو كأنه يجمع بين خصائص السائل والغاز في آن واحد.
الأمر الأكثر إثارة للدهشة هو قدرة الهيليوم السائل على توصيل الحرارة بكفاءة مذهلة. عند نقطة “دلتا”، يتفوق الهيليوم السائل في نقل الحرارة على النحاس في درجة حرارة الغرفة بأكثر من 500 مرة، مما يمثل لغزًا محيرًا للفيزيائيين والكيميائيين.
وأوضح البروفيسور فريتز أن فهم هذه الظاهرة يصبح ممكنًا إذا نظرنا إلى الهيليوم السائل من منظور نظرية بوز-أينشتاين، مستعينين بالمعادلات التي وضعها أينشتاين في عشرينيات القرن الماضي. وأضاف أن مفاهيم التوصيل الكهربائي في المعادن قد تساهم في تفسير هذه السيولة الفريدة.
ولتقريب الفكرة، يمكن تشبيه سلوك الهيليوم السائل بحركة الإلكترونات في المعادن، التي تُفسر ظاهرة التوصيل الكهربائي. بهذا التشبيه البسيط، يتجلى تكامل الأفكار الفيزيائية في تقديم فهم أعمق للظواهر الأكثر تعقيدًا في عالم المادة.
في عالم الطب والصحة العامة، تصدّر علم البكتيريا المشهد لأكثر من نصف قرن، حاملاً في طياته قصصًا ملهمة عن الإبداع والفضول العلمي. فما هي حكاية هذا العلم؟
بعد الحرب الفرنسية البروسية عام 1870، أسست الحكومة الألمانية جامعة ستراسبورغ الشهيرة، ليكون أول أستاذ لعلم التشريح فيها هو فيلهلم فون فالديير (Wilhelm von Waldeyer). وفي مذكراته، يروي فالديير أنه في أول فصوله الدراسية، لفت انتباهه طالب شاب، هادئ الطباع ومفعم بالاستقلالية، يبلغ من العمر سبعة عشر عامًا فقط، ويدعى بول إرليخ (Paul Ehrlich).
رغم أن دراسة التشريح في تلك الحقبة اعتمدت بشكل أساسي على التشريح المباشر وفحص الأنسجة تحت المجهر، إلا أن إرليخ بدا مختلفًا. لم يكن يولي اهتمامًا كبيرًا للجوانب التقليدية، بل انشغل بأشياء أخرى.
كان مكتبه يتحول تدريجيًا إلى لوحة متناثرة بالبقع الملونة، مما أثار فضول فالديير. وفي إحدى المرات، اقترب منه ليسأله عن سر تلك الألوان الزاهية. أجاب إرليخ بجملة مقتضبة لكنها عميقة المعنى: “أنا ألهو وأجرب.” ابتسم له فالديير وقال: “استمر في لهوك واستكشافك.”
ترك فالديير إرليخ ليتابع شغفه، مدركًا أنه أمام موهبة فريدة. وهكذا، استمر إرليخ في تجاربه التي بدت آنذاك عبثية، لكنها استندت إلى حدس علمي عميق. وبفضل هذا الشغف، ساهم إرليخ في تأسيس علم البكتيريا، الذي تطور لاحقًا على يد كوخ وزملائه. كما أنه ابتكر تقنيات لصبغ الدم، مما أتاح للطبيب الحديث فهماً معمقًا لكريات الدم الحمراء والبيضاء، وأصبحت تقنياته أساسًا لفحوص الدم التي تُجرى يوميًا في آلاف المستشفيات حول العالم.
ما كان يومًا مجرد تجارب بسيطة في غرفة تشريح بستراسبورغ، تحول إلى إنجاز طبي غيّر مجرى التاريخ.
ولا يقتصر الإبداع العلمي على الطب وحده؛ ففي مجال الصناعة، تتكرر القصص الملهمة. يروي البروفيسور بيرل من معهد كارنيجي للتكنولوجيا قصة الكونت الفرنسي شاردونيه (Chardonnet)، مؤسس صناعة الرايون الحديثة.
ابتكر شاردونيه تقنية تعتمد على محلول من قطن النيترو ممزوجًا بالإيثر والكحول، حيث يُضغط الخليط عبر أنابيب دقيقة إلى الماء، لتتخثر خيوط نترات السليلوز. لكن حدثت مفاجأة غيّرت مجرى الصناعة.
أثناء أحد الأيام في مصنعه في بيزانسون، تسبب عطل في انقطاع المياه اللازمة لتخثر الخيوط. ولدهشة العمال، اكتشفوا أن العملية أصبحت أكثر كفاءة وفعالية بدون الماء. ومن هذه المصادفة، وُلدت تقنية الغزل الجاف، التي أصبحت فيما بعد من أعمدة الصناعة الحديثة.
هكذا، سواء في مختبرات العلم أو مصانع الصناعة، يكمن وراء كل إنجاز عظيم شغف بالتجربة وفضول لا يعرف الحدود. هذه هي الحكاية الدائمة للإبداع البشري.
******
لا أدّعي أن كل ما يجري في مختبرات العلم سيثمر بالضرورة عن استخدام عملي، ولا أزعم أن الفائدة المباشرة هي المبرر الأوحد لكل جهد علمي. لكنني أدعو إلى التحرر من قيود فكرة “الفائدة” الضيقة، وإطلاق العنان للروح الإنسانية لتغوص في أعماق المجهول. قد يبدو السماح لبعض ذوي العقول الغريبة بمواصلة تجاربهم التي تبدو غير ذات جدوى هدرًا للأموال والموارد، لكنه في الحقيقة تحرير للعقل البشري، ودعوة لفتح أبواب المغامرة أمام الإنسانية، كما فعل هايل، وراذرفورد، وأينشتاين، وغيرهم من الرواد الذين وسعوا حدود معرفتنا بالعالم والكون.
لم يكن دافع راذرفورد، أو بور، أو ميليكان هو البحث عن استخدامات عملية لأبحاثهم، بل كان شغفهم هو فهم الذرة وكشف أسرارها. وبهذا الفضول البحت، حرروا طاقات هائلة غيرت مجرى التاريخ. لم تكن النتائج العملية المذهلة لأعمالهم تبريرًا لما قاموا به؛ لأن الإبداع العلمي الحقيقي لا يخضع لأوامر أو تعليمات. لا يمكن لأي مدير أو مؤسسة أن تُوجه العقول العظيمة نحو وجهات محددة، فهذه العقول تعمل في فضاء الحرية، وتبدع حين تُترك لاستكشاف المجهول دون قيود.
قد يُنظر إلى ما يُنفق على العلوم البحتة مثل علم البكتيريا كهدر، لكنه هدر لا يُقاس أمام الفوائد الجليلة التي جلبتها اكتشافات أمثال باستور، وكوخ، وإرليخ، وثيوبالد سميث. هؤلاء العلماء، الذين كانوا بحق فنانين في مجالاتهم، لم تُقيدهم فكرة الفائدة المباشرة. قادهم شغفهم بالبحث إلى اكتشافات غيرت وجه العالم، وألهمت أجيالًا كاملة لتبني النهج نفسه في مختبرات العلم.
ليس انتقادي موجهًا إلى المؤسسات التي تقوم على الغايات العملية، مثل كليات الهندسة والقانون، فهذه ضرورة لا غنى عنها. بل إن من المثير للإعجاب أن كثيرًا من الإنجازات النظرية العظيمة وُلدت من رحم المشكلات العملية التي واجهت الصناعة أو المختبرات. هذه المشكلات حفزت أسئلة نظرية قد لا تجد حلولًا فورية، لكنها فتحت آفاقًا جديدة، قد تكون في البداية بلا جدوى ظاهرة، لكنها تحمل بذور إنجازات عظيمة مستقبلًا، سواء في الإطار العملي أو النظري.
حين نتأمل تراكم المعرفة التي تبدو “غير مفيدة”، نجد أنها كانت الأساس الذي بُنيت عليه الإنجازات الكبرى. حل المشكلات العملية يمكن أن يكون دافعًا للعلم الخالص، كما أن العلماء البحتين غالبًا ما يساهمون في التطبيقات العملية. ماركوني، على سبيل المثال، استفاد من أفكار العلماء الذين سبقوه، وصاغ منها أدوات أفادت البشرية. إديسون، رغم عظمته، يمكن أن يُنظر إليه كمن بَنَى على اكتشافات الآخرين، لكنه كان رجل تطبيقات أكثر منه رجل نظريات. أما باستور، فقد كان حالة فريدة جمعت بين شغف العالم وعبقرية حل المشكلات اليومية.
واجه باستور تحديات مثل أزمة كروم العنب الفرنسية أو تحسين تخمير البيرة، ولم يكتفِ بحلها، بل صاغ منها استنتاجات نظرية أثرت بعمق على العلوم. ما بدا حينها اكتشافات “بلا فائدة” أصبح ركيزة لثورة علمية لاحقة، تُثبت أن شغف البحث لا حدود له، وأن الفضول العلمي هو مفتاح التقدم البشري الحقيقي.
انطلق بول إرليخ بدافع فضوله العلمي ليخوض معركته ضد مرض الزهري، مسخرًا جهوده حتى توصل إلى العلاج المعروف بالسالفارسّان. وعلى النهج ذاته، جاء اكتشاف الأنسولين على يد بانتينغ لعلاج السكري، واستُخلص الكبد من قِبل مينوت وويبل لعلاج فقر الدم الخبيث. لم تكن هذه الإنجازات سوى ثمار تراكم ذلك العلم الذي “لا ينفع” الذي شكل البنية التحتية لهذه الاكتشافات العظيمة.
يتضح لنا أن الاكتشاف العلمي ليس وليد لحظة عبقرية منفردة، بل هو نتاج سلسلة متصلة من الجهود التي تتضافر عبر الزمن. يبدأ كل اكتشاف برؤية صغيرة تتطور على أيدي عقول مختلفة، حتى تكتمل الصورة النهائية بلمسة عبقري قادر على جمع الأجزاء المتناثرة ليُحدث الأثر الحاسم. وكما يبدأ نهر الميسيسيبي بجدول صغير ينساب في أعماق الغابة، ليتلقى تيارات عديدة ويصبح نهرًا عظيمًا يفيض بقوة، كذلك هو العلم: بناء يتدفق من مصادر شتى.
رغم أنني لا أستطيع التوسع في هذا الجانب، إلا أنني أؤكد أن مساهمات المدارس المهنية، على مدى قرن أو أكثر، لن تقتصر على تخريج المهندسين أو الأطباء أو المحامين، بل تتجلى قيمتها في إفساح المجال لأنشطة تبدو بلا غاية ظاهرة. هذه الأنشطة، التي قد يعتبرها البعض عبثية، هي الجذور التي تُنبت أعظم الاكتشافات.
إن التأمل في هذه الحقيقة يكشف عن القيمة العظيمة للحرية الفكرية والروحية، تلك الحرية التي تُشكل جوهر التجربة الإنسانية. في العلوم والرياضيات، كما في الفن والموسيقى، السعي نحو المعرفة والإبداع يُبرَّر بذاته، لأنه يلبي حاجة الروح البشرية إلى السمو والارتقاء.
تكتسب مؤسساتنا الأكاديمية قيمتها الحقيقية عندما تكون فضاءات لتحرير العقول والقلوب من قيود الفائدة المباشرة وشروط التطبيق. قصيدة ملهمة، سيمفونية متقنة، لوحة تُحرك الوجدان، أو اكتشاف علمي عميق، كلها تُبرر بذاتها وجود هذه المؤسسات دون حاجة إلى أي تفسير إضافي.
ومع ذلك، نجد أنفسنا اليوم في زمن تتعرض فيه الحرية الفكرية لتهديدات خطيرة، كما هو الحال في بعض الدول حيث حُوِّلت الجامعات إلى أدوات تخدم عقائد سياسية أو اقتصادية أو عرقية ضيقة. العدو الحقيقي للإنسانية ليس نقص الموارد أو المشكلات التقنية، بل هو محاولات تقييد الروح البشرية ومنعها من التحليق.
هذه الحرية التي امتدت جناحيها يومًا في دول مثل ألمانيا وإيطاليا وبريطانيا والولايات المتحدة، كانت هي القوة الدافعة وراء أعظم إنجازات الفكر والإبداع. وهي ذات الفكرة التي ألهمت فون هومبولت لتأسيس جامعة برلين وسط محنة غزو نابليون، والتي دفعت جيلمان لوضع حجر الأساس لجامعة جونز هوبكنز، لتصبح نموذجًا تحتذي به الجامعات في الولايات المتحدة، وإن بدرجات متفاوتة.
إن مبرر الحرية الروحية لا يقف عند حدود الفكر أو الفن، بل يتجاوز ذلك ليصبح تعبيرًا عن أرقى أشكال التسامح مع الاختلافات البشرية. إن تاريخ الإنسانية يثبت أن عبثية التمييز بين الإبداع على أسس عرقية أو دينية أو قومية هي أحمق ما يمكن أن ترتكبه البشرية.
فهل نطمح إلى سيمفونيات ولوحات واكتشافات علمية تعبّر عن حقيقة الإنسان، أم إلى إبداعات مسيحية أو يهودية أو إسلامية مقيدة بأطر ضيقة؟ الحقيقة التي لا جدال فيها هي أن عظمة الروح البشرية تكمن في تنوعها، وأن هذا التنوع يغني التجربة الإنسانية ويثريها بلا حدود.
من بين أبرز نتائج السياسات القمعية التي مارستها بعض الأنظمة الأجنبية، يبرز معهد الدراسات المتقدمة (Institute for Advanced Study) كقصة ملهمة للتحدي والإبداع. هذا المعهد العريق، الذي أسس عام 1930 بجهود السيد لويس بامبرغر وشقيقته السيدة فيليكس فولد، يمثل رمزًا للحرية الأكاديمية وتكريمًا للعقول العظيمة.
اختيرت برينستون مقرًا لهذا المعهد، ليس فقط لارتباط المؤسسين العاطفي بولاية نيو جيرسي، بل أيضًا لما تمتاز به برينستون من مدرسة دراسات عليا صغيرة ذات جودة أكاديمية استثنائية. ومنذ انطلاقه، استفاد المعهد من دعم جامعة برينستون، التي قدمت مواردها الغنية من مكتبات ومختبرات، فضلًا عن استقطاب علماء بارزين من هيئة تدريسها.
شهد عام 1933 انطلاقة المعهد الحقيقية بفضل فريقه الأكاديمي اللامع، الذي ضم أسماءً رائدة مثل فيبلن، وألكسندر، ومورس في الرياضيات، وميريت، ولو، والسيدة جولدمان في العلوم الإنسانية، وستيوارت، وريفيلر، وميتراني في الاقتصاد والسياسة. ولم يكن هذا إلا البداية.
للمفارقة، يعود جزء كبير من نجاح المعهد إلى السياسات القمعية التي فرضها النظام النازي في ألمانيا، والتي دفعت عباقرة مثل أينشتاين، وفايل، وفون نيومان، وهرزفيلد، وبانوفيسكي للهجرة إلى الولايات المتحدة. هؤلاء العلماء، إلى جانب الشباب الواعد الذي انضم لاحقًا، أسسوا قوة فكرية هائلة ساهمت في نهضة الفكر والعلم، وأكدت على أهمية الحرية الأكاديمية كركيزة للتقدم الإنساني.
يمثل معهد الدراسات المتقدمة نموذجًا فريدًا للتنظيم الأكاديمي البسيط والفعّال. يتألف من ثلاث مدارس: مدرسة الرياضيات، مدرسة الدراسات الإنسانية، ومدرسة الاقتصاد والسياسة. تضم كل مدرسة مجموعة من الأساتذة الدائمين والأعضاء المتجددين، الذين تتغير عضويتهم سنويًا. يتمتع الجميع بحرية تامة لإدارة وقتهم وجهودهم كما يرون مناسبًا، دون قيود بيروقراطية أو تدخل إداري.
يوفر المعهد بيئة استثنائية تذوب فيها الحواجز بين الأساتذة والأعضاء والزوار. يتمتع الجميع بحقوق متساوية، ويُتاح لهم التعاون بحرية، أو العمل في عزلة تامة إذا ما اقتضت أبحاثهم ذلك. لا اجتماعات تُعقد، ولا لجان تُشكل، مما يخلق بيئة مثالية للتأمل والإبداع.
إن هذه البساطة الإدارية لا تتسامح مع الجمود أو التهاون؛ فالمعهد هو موطن للعقول اللامعة فقط. عالم الرياضيات قد يغرق في معادلاته دون إزعاج، والمفكر الإنساني يستمر في استكشافاته، والاقتصادي يصيغ نظرياته، دون تدخل أو مقاطعة. أما من يفتقر إلى الفكرة أو القدرة على التركيز، فلن يجد في هذا المكان مأواه.
هكذا، يظل معهد الدراسات المتقدمة شاهدًا على قوة الحرية الأكاديمية، ومنارة تلهم المؤسسات الأكاديمية حول العالم بأن الإبداع الإنساني يزدهر في أجواء التحرر والانفتاح، بعيدًا عن قيود البيروقراطية وضغوط الإنتاجية المباشرة.
لإيضاح فكرتي حول أهمية الحرية الأكاديمية، سأشارك بعض الأمثلة المباشرة. ذات مرة، حصل أحد أساتذة جامعة هارفارد على منحة دراسية للقدوم إلى برينستون. كتب لي بحماس سائلاً: “ما هي واجباتي؟” فأجبته ببساطة: “ليس لديك أي واجبات، لديك فقط فرص”.
ومن هذه الفرص، حكاية شاب نابغٍ في الرياضيات قضى عامًا في برينستون. عندما حان وقت رحيله، سألته عما يعنيه له هذا العام. أجابني قائلاً: “لقد كانت الرياضيات تتقدم بوتيرة مذهلة، والمراجع الأكاديمية تتزايد بشكل مرهق. مضى أكثر من عقد على حصولي على درجة الدكتوراه، وأصبحت متابعة التطورات معقدة وشاقة. لكن هذا العام هنا كان كرفع الستائر عن نافذتي، حيث امتلأت الغرفة بالضوء والنوافذ انفتحت على مصراعيها. لدي الآن فكرتان لبحثين جديدين، وسأبدأ الكتابة قريبًا”.
سألته بفضول: “وإلى متى ستستمر هذه الحالة من الإلهام؟” فأجاب: “ربما خمس سنوات، وربما عشر”. قلت: “وماذا بعد ذلك؟” فابتسم بثقة قائلاً: “سأعود!”.
مثال آخر يروي قصة أستاذ جامعي من الغرب الأمريكي جاء إلى برينستون في ديسمبر للعمل مع البروفيسور موري. نصحه موري بأن يلتقي أيضًا بالبروفيسور بانوفيسكي وسفارزنسكي. وها هو يجد نفسه مشغولًا معهم جميعًا، ويقول مبتسمًا: “سأبقى حتى أكتوبر”. وعندما حذرته من حرارة الصيف، أجاب: “سأكون منشغلًا وسعيدًا جدًا لدرجة أنني لن ألاحظ ذلك!”.
الحقيقة أن الحرية الأكاديمية هنا لا تُنتج الركود، بل قد تحمل خطر الإفراط في العمل. أحد الأعضاء الإنجليز علق مازحًا: “هل يعمل الجميع هنا حتى الثانية صباحًا؟”.
ورغم عدم وجود مبنى رسمي للمعهد بعد، فإن العمل يجري بتناغم. الرياضيون يستضيفهم مبنى فاين بجامعة برينستون، الدارسون للعلوم الإنسانية يجدون مكانهم في قاعة مكورميك، والاقتصاديون يعملون في أجنحة فندق برينستون إن. أما مكتبي، فهو متواضع، يقع بين متاجر البلدة ومكاتب المحامين والأطباء. ومع ذلك، نفتقد الروابط غير الرسمية التي تعزز التفاعل الفكري، وهو ما سنعالجه قريبًا ببناء قاعة “فولد”، التي ستُحافظ على طابع البساطة والمرونة الذي يُميز معهدنا.
لا نطلق وعودًا محددة، بل نغذي الأمل بأن البحث الحر وغير المقيّد عن المعرفة، مهما بدا “علمًا لا ينفع”، سيظل يثمر، تمامًا كما فعل في الماضي وسيفعل في المستقبل.
مع ذلك، فإن قيمة هذا المعهد لا تُقاس فقط بنتائجه، بل بما يمثله. إنه جنة للعلماء، كما هو للشعراء والموسيقيين، الذين اكتسبوا بحق الحرية الكاملة للسير وفق إبداعاتهم الخاصة. عندما تُتاح لهم هذه الحرية، يحققون أعلى مراتب الإنجاز ويتركون بصماتهم الخالدة في سجل الإنسانية.