الزمان سنة 133 قبل الميلاد، والمكان روما. تيبريوس جراكوس -محامٍ عن العامة- مقتولٌ في الشوارع مع ثلاثمائة من مناصريه، كان قد أغضب الكثيرين في مجلس الشيوخ برعايته لتشريعٍ مُعادٍ للأرستقراطية السياسية، يتعلّق تحديدًا بإعادة توزيع الأراضي، وتقليص مدة الخدمة العسكريّة، وتوسيع نطاق الوصول للامتيازات الخاصّة بالمواطن الروماني. إنّها حلقة ذائعة الصيت في تاريخ روما القديمة.
الأمر الأقل شهرة هو أنّ تيبريوس كان قد نُصِح من قبل فيلسوف رواقي: جايوس بلوسيوس (Gaius Blossius)، وهو واحدٌ من الأمثلة العديدة لرواقيين شديدي الاشتباك مع السياسة والإصلاحات المجتمعيّة. عَمِلَ جايوس لسنوات مع تيبريوس لتحسين أحوال العامة. عندما رأى صديقه يُذبح، غادر روما وقرّر أن وقت اللعب ضمن القواعد قد ولّى. يخبرنا بلوتارخس أنّ بلوسيوس انتقل إلى مقاطعة آسيا (غرب تركيا المعاصرة) حيث انضمّ إلى ثورة ضد روما بقيادة يومينس الثالث (Eumenes III) الذي كان مُدعيًا لأحقيّته في عرش بيرغامون.
كان النجاح حليف الثورة في البداية، وتمكّن يومينس من احتلال عدد من المدن في أناطوليا، واحتلال جزيرة ساموس (Samos) -حيث وُلد كلّ من فيثاغورس وإبيقور- وقتل القنصل الروماني بيبليوس ليسينيوس كراسوس (Publius Licinius Crassus). إلا أنّ مجلس الشيوخ الروماني أرسل قنصلًا آخر متمرّسًا -ماركوس بيربيرنا (Marcus Perperna)- في نهاية الأمر إلى المقاطعة، والذي تمكّن من القضاء على الثورة. عندما فشلت الانتفاضة أقدم بلوسيوس على الانتحار، في تصرفٍ رواقيّ نمطي.
شهدت الرواقيّة إحياءً مفاجئًا في السنوات الأخيرة، وأصبحت فلسفة شائعة للحياة، كنوع من الرد الغربي على البوذيّة (والتي تمتلك الكثير المشترك معها)، غير أنّها بقيت موضع عددٍ من الانتقادات، بعضها ذو حيثيّة أكثر من الآخر. على الرغم من الحلقات المتعددة مثل تلك التي تظهر بلوسيوس (Blossius)، يدّعي نقّاد الرواقيّة المعاصرون أنّها متمحورة حول الذات وتفتقر الموارد للاحتكاك بشكل ذي مغزى على المستوى السياسي.
على سبيل المثال، في كتابه تجاهَل، تولَّ المسئوليّة (Tune Out, Lean In) (2021)، وهو رصدُه لصالح مراجعة نيويورك للكتب (The New York Review of Books) لعدد من المجلدات عن الرواقيّة، يشير جريجوري هايس (Gregory Hays) -باحث كلاسيكي ومترجم للإمبراطور الرواقيّ: ماركوس أوريليوس (Marcus Aurelius)- إلى أنّ الرواقيّين القدماء عارضوا الطغاة الأفراد مثل نيرون، لكنّهم لم يعارضوا مبدأ الطغيان نفسه. روّج الرواقيّون لمعاملة العبيد كبشر مستحقّين للكرامة والاحترام، لكنّهم لم يروّجوا للقضاء على العبوديّة كمشروع. سبقَ الرواقيّون عصرهم في اعتبار النساءِ مُمتلِكات لنفس القدرة الفكريّة كما الرجال، لكنّهم فشلوا في الوصول لأي سياسات متكاملة للمساواة بين النوعين.
فيما بتعلّق بأنظمة الحكومات، يكتب هايس: “الرابط بين الرواقيّة والاستبداد هو رابط طبيعي بشكلٍ ما. في نهاية الأمر فالرواقيّة تتعلّق بتحكّم الفرد في أفكاره ومشاعره، أن يكون حاكمًا مطلقًا في قلعة العقل”. من تبعات ذلك -بالنسبة للرواقي- ألّا يهم أي نظام سياسي يُطبَّق، فالفيلسوف يستبقي القدرة على ممارسة الفضيلة على حالها بغض النظر عن الظروف الخارجيّة.
معلّقًا على العبوديّة، يقول هايس: “خطابات سينيكا الأخلاقيّة تُقتبس أحيانًا كدليل على اتجاه أكثر استنارة. يمكن تلخيص الرسالة في خطابه السابع والأربعين في أنّ “العبيد هم بشرٌ أيضًا”. لكنّ اعتراضات سينيكا مشكلّة تقريبًا بالكامل حول الأذى المتصوَّر الذي تحدثه العبوديّة لشخصيّة مالك العبد”.
لكن حلقة بلوسيوس ليست بالتأكيد استثناءً في التاريخ الرواقي. رواقيٌ شهير آخر حمل السلاح ضد ما اعتبره طغيانًا كان كاتو الأصغر (Cato the Younger)، العدو اللّدود ليوليوس قيصر (Julius Caesar). كان كاتو معروفًا في زمانه بامتلاكه مستوى عاليًا من النزاهة الشخصيّة؛ حيث كان الناس إذا أرادوا منح أنفسهم عذرًا لفشل أخلاقي ما كانوا يقولون: “حسنًا، ليس بوسع الجميع أن يكون كاتو!”.
حارب كاتو قيصر في مجلس الشيوخ لسنين، لكن عندما بدأ الأخير حربًا أهليّة اتّبع كاتو مثال بلوسيوس وحمل السلاح للحفاظ على بلاده. لم ينجح كاتو، لكن اسمه بقي إلى اليوم مرادفًا للدفاع عن الحريّة. جعل جورج واشنطون مسرحيّة جوزيف أديسون عن كاتو تُؤدَّى ذات مرة لجيشه الثوري لإلهامهم ليحاربوا الاستعمار البريطاني.
ربما أكثر مثال شامل للاحتكاك الرواقيّ بالسياسة هو ما يُسمّى بالمعارضة الرواقيّة، وهي مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ والفلاسفة في روما القديمة الذين عارضوا بنشاط طغيان ثلاث أباطرة: نيرون وفسبازيان ودوميتيان. من ضمن هؤلاء يُقدِّم هيلفيديوس بريسكوس (Helvidius Priscus) نموذجًا مميّزًا، كما أخبرنا ابيكتيتوس (Epictetus) -معلم القرن الثاني الرواقيّ الشهير- في المحادثات الخاصّة به:
عندما أرسل فسبازيان خطابًا إلى هيلفيديوس بريسكوس ليخبره ألّا يحضر اجتماعًا لمجلس الشيوخ أجابه:
“بمقدورك أن تمنعني أن أكون من أعضاء مجلس الشيوخ، لكن طالما أنا عضو فينبغي عليّ حضور اجتماعات المجلس”. –”حسنًا، إذا كنت ستحضر، فلتبقِ فمك مغلقًا.” –”إذا لم تطلب رأيي فسأبقي فمي مغلقًا.” –”لكنّي مضطر لطلب رأيك.” –”وأنا بدوري ينبغي عليّ الردُّ بما أراه ملائمًا.” –”لكن إذا فعلت ذلك فسأضطر إلى إعدامك.” –”حسنًأ، ومتى زعمت لك أنّي خالد؟ أنت تؤدي دورك، وأنا سأودي دوري. دورك هو قتلي، ودوري أن أموت بلا اختلاج أو رجفة، دورك أن ترسلني إلى المنفى ودوري أن أغادر بلا تأنيب ضمير.”

ما الذي أحرزه بريسكوس إذًا، قد تتساءل، بكونه مجرد فرد وحيد؟ وأي أمر جيد يضيفه اللون الأرجواني للرداء، أهناك أمر آخر باستثناء كونه يقف هناك أرجوانيًا، ويقدّم قدوة حسنة للبقيّة؟
نُفي بريسكوس أولًا ثم قُتل بأمر من فسبازيان لكن -كما يقول ابكتيتوس- تضحيته لم تذهب سُدى، لأنّها ألهمت العديدين من بعده ليكملوا المعركة ضد القمع. بالطبع فإن واحدًا ممن ألهمهم بريسكوس كان ماركوس أوريليوس (Marcus Aurelius) الإمبراطور الفيلسوف الذي تخبرنا التأملات الخاصة به:
“لقد كان من خلال أخي سيفيروس أنّي علمت عن ثراسيا وهيلفيديوس وكاتو وديو وبروتس، وأنّي تخيّلت فكرة دستور متوازن، وحكومة مبنية على أساس من القسط وحريّة التعبير، وملَكيّة تقدّر حرية الرعيّة فوق كل اعتبار”.

هذه الأمثلة وأخرى مشابهة تظهر وجود العديد من الأدلة التاريخيّة على أنّ الرواقيين عارضوا الاستبداد ودافعوا عن مثالٍ لمجتمع تُميّزه الحريّة والخطاب الحر. بالطبع ينبغي فهم هذا في نطاق قيود الثقافة لذلك الزمن. عندما عارض كاتو القيصر، كان يفكّر في الحريّة للرجال البيض غير المستعبدين، ولا يجدر بنا ترجمة أشخاص مثل بريسكوس والآخرين الذين ذكرهم ماركوس على أنّهم مماثلون بأي شكل للنماذج المعاصرة مثل مارتن لوثر كينج أو نيلسون مانديلا.
بعد ما قيل، فإن هذه الأمثلة تُثبِت فقط أنّ عددًا من الأفراد الرواقيّين -وإن كانوا بارزين- قد تورّطوا سياسيًا بالفعل، أحيانًا إلى حد المخاطرة بحياتهم وحريّتهم. على الرغم من ذلك فهذا ليس مساويًا لإثبات أنّ الفلسفة الرواقيّة تتطلَّب من ممارسيها أنّ يكونوا متورطين سياسيًا بشكل قد يودي بهم -إذا تطلّبت الظروف- إلى الوصول لحد التشكيك في النظام وليس مجرد الأفراد الفاعلين داخله. قد تعرف المزيد في ما تغفله الرواقية الشعبية عن الفلسفة.
وحده رابط واضح بين الفلسفة الرواقيّة وأفعال الرواقيّين سيكون كافيًا للإجابة على مخاوف أشخاص مثل هايس؛ وعند هذه النقطة تزداد الأمور تعقيدًا وتشويقًا بشكل ملحوظ.
التوثيق المعتاد الذي يقرؤه المرء في دوائر الرواقيّين المعاصرة هو أنّ مبدأين متقاطعين يشكلان أساس النشاط السياسيّ في الرواقيّة: الاستيعاب (oikeiôsis) والكونيّة. الاستيعاب (oikeiôsis) هو مصطلح تصعب ترجمته إلى الإنجليزيّة، ولكنّه يشير إلى “استيعاب” مخاوف الآخرين. طوّر الرواقيّون نظريّة متقدّمة عمّا بوسعنا تسميته علم النفس الأخلاقيّ التطوّري. طبقًا للرواقيين فإنّنا نولد أنانيين، نتصرف بشكل غريزي للحفاظ على ذواتنا إلى الحد الأقصى؛ لكنّنا فورًا -وبشكل طبيعي- نطوّر روابط مع بشرٍ آخرين، أكثرها وضوحًا تلك مع آبائنا وإخوتنا.
لاحقًا نصل إلى سن الرشد، وعند هذه النقطة نبدأ في التفكير بمفاهيم أكثر تجريدًا، وندرك بالتدريج أنّ البشر جميعًا -بغض النظر عن شكلهم أو أصلهم- يشتركون في جميع الاحتياجات والرغبات، ويمتلكون نفس المخاوف والآمال مثلنا. يتبع هذا منطقيًا إذًا أنّه ينبغي علينا اعتبار الآخرين جميعهم إخوة وأخوات لنا (أو أي نوعٍ اجتماعي آخر قد نضيفه في هذه الايام). هذا التوسّع المستمر لدوائر مخاوفنا -كما سمّاه الفيلسوف النفعيّ المعاصر بيتر سنجر (Peter Singer)- يقود الرواقيين مباشرة إلى المفهوم الثاني الذي يجعل من التحرّك المجتمعيّ والسياسي واجبًا علينا كبشر: الكونيّة. كما يصيغ ابكتيتوس (Epictetus) الأمر في المحادثات:
لتفعل كما فعل سقراط، بعدم إجابته مطلقًا على سؤال من أين ينحدر أصله بالقول “أنا أثيني” أو “أنحدر من كورنث؛” بل بالإجابة دائمًا “العالم هو وطني”.
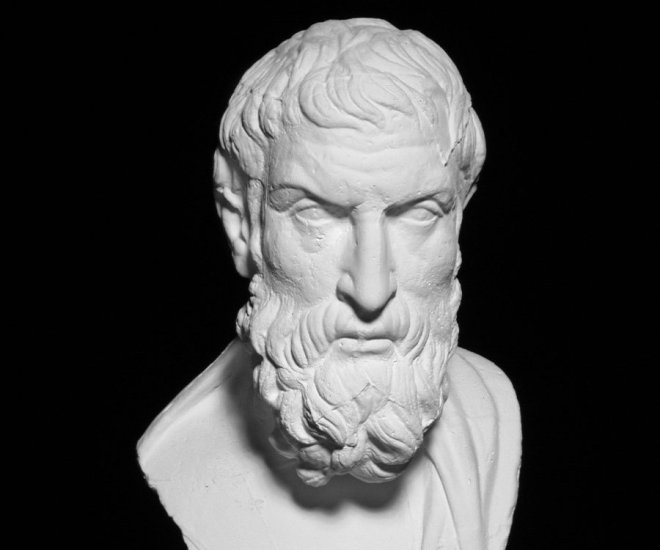
نموذج معاملة كل البشر الآخرين -والحيوانات الأخرى كما كان بعض الرواقيين المعاصرين ليذهبوا إلى القول- باعتبارهم يمتلكون قيمة متأصّلة وكرامة يمكن بالتأكيد تحقيقه بعدد من الطرق اعتمادًا على الظروف على أرض الواقع؛ لذلك فالرواقيّة تمتلك قابليّة التوافق مع قَدر من المسارات السياسيّة المحدّدة، رغم كونها غير متوافقة مع كل المسارات بالتأكيد (سيكون تناقضًا في اللغة على سبيل المثال الحديث عن فاشيّة رواقيّة).
لا يمكن فرض الطريق نحو عالم أفضل من الأعلى، فهو يمرُّ عبر كل واحدٍ منّا
بشكل عام، أخلاقيّات الفضيلة -والتي تعدُّ الرواقيّة تجسيدّا معيّنًا لها، مع الأبيقوريّة والأرسطيّة والكونفوشيوسيّة ضمن آخرين- يميّزها مفهوم أنّ الإجابة “الصحيحة” لسؤال كيف يجدر بنا التصرُّف هو دائمًا “هذا يعتمد على السياق”. ليست هذه نسبيّة أخلاقيّة أو ضعف شخصيّة، إنّه اعترافٌ بأنّ المجتمعات الإنسانيّة والعلاقات متنوّعة ومعقّدة، وأنّ ما يصلح في ظروف معيّنة قد لا يصلح في أخرى.
الأمر المهم -يقول الممارسون الحديثون للرواقيّة- هو أن يستقرّ عميقًا داخل الفرد إطار راسخ يتضمّن المفاهيم العالميّة مثل الاستيعاب (oikeiôsis) والكونيّة، وأنّ نقوم بما في وسعنا لنتصرّف وفقًا له. العدل بالنسبة للرواقيّ ليس مجموعة من المفاهيم المجرّدة، بل هو نزوعٌ شخصي للتصرّف بشكل محدّد تجاه الأقران من البشر؛ أنّ نعاملهم باحترام ونزاهة بالشكل الذي نريد نحن أن يعاملنا به الآخرون. لا يمكن فرض الطريق نحو عالم أفضل من الأعلى -يظن الرواقيّون- فهو يمرُّ عبر كل واحدٍ منّا بشكل فردي، تمامًا كما تصرُّ التقاليد الفلسفيّة والدينيّة العظمى لما يقارب آلاف السنين الآن.
كل هذا يبدو جيّدًا، لكن هل يُترجَم الاستيعاب الرواقيّ والكونيّة إلى أي نوع من الخطة السياسيّة؟ هل بوسعهما منحُنا الحافز لمحاربة الظلم المنهجي وليس فقط الفردي؟ أخشى أنّ الإجابة سلبيّة، وهذه مشكلة جديّة للرواقيّين المعاصرين.
لنأخذ فكرة الكونيّة؛ طبقًا لجون سيلارز (John Sellars ) -واحد من أبرز الباحثين في الرواقيّة- كاتبًا في 2007؛ طوّر الرواقيّون المفهوم من من سقراط والكلبيّين أولاد عمومته في الفلسفة. بالطبع فإنّ ديوجانس الكلبيّ الشهير -الشخص الذي أخبر الإسكندر الأعظم أنّ يتفضّل ويتنحّى بعيدًا عن مرمى بصره لأنّه يحجب الشمس- كان على ما يبدو من ابتدع المصطلح “مواطن عالمي” (kosmopolitês في الإغريقيّة).
لكنّ فكرة العالميّة الكلبيّة الرواقيّة لم تكن برنامجًا سياسيًا من أي نوع، عوضًا عن كونها يوتوبيا نخبويّة. كانت الفكرة أنّ الحكماء -أي الكلبيِّين والرواقيِّين المثاليِّين- سينجذبون بشكل طبيعي إلى بعضهم البعض ويكونون مجتمعًا من الحكماء والحكيمات والذي سيتخطّى الأصول والحدود الجغرافيّة. بديهيًا فلن ينطبق هذا على معظم العامة من الناس، والذين اعتبرهما كلّا التقليدان الفلسفيّان حمقى غير فاضلِين. إحقاقًا للحق فهذا يبدو أسوأ مما كان عليه في واقع الأمر؛ فكلّ مؤلف رواقيّ نعلم عنه -بداية من سينيكا ووصولًا لماركوس أوريليوس- كان أيضًا ليعتبر نفسه أحمقًا. بالإضافة لما سبق، ليس الأمر كما أنّه كانت لتوجد وفرة في الحكماء، في واقع الأمر وطبقًا لسينيكا:
(الحكيم) قد يظهر للوجود -مثل العنقاء- مرة فقط كلّ خمسمائة عام
هذا الافتقار لبرنامج سياسي على جانب الرواقيّين كان مُعترفًا به بالفعل في العصور القديمة. كان ماركوس تليوس سيسرو (Marcus Tullius Cicero) -رجل الدولة والخطيب والفيلسوف- شديد التعاطف مع الرواقيّة، رغم أنّ فلسفة حياته المختارة كانت تُعرف بالشكوكيّة الأكاديميّة (Academic Scepticism) والتي سُميّت أكاديميّة لأنّ الشكوكيين سيطروا على أكاديميّة أفلاطون ما بين عامي 266 و90 قبل الميلاد. كان سيسرو هو من تبنّى أفكارًا رواقيّة -تحديدًا من بانتيوس الرودسي الرواقيّ- ورَسَم رؤية لما قد تكون عليه دولة حقيقيّة مُسترشدة بمبادئ فلسفيّة. نُشرت النتيجة من قبل سيسرو في كتابين: عن الدولة (De Re Publica ) وعن الواجبات (De Officiis )، وُصف الأخير من قبل فريدريك العظيم (Frederick the Great) بأنّه أعظم عمل عن الأخلاق كُتب أو يمكن أن يكُتب.
ماذا عن الصراع السابق ذكره ضد الاستبداد كما تجسّد في أعضاء المعارضة الرواقيّة؟ يشير باحث شهير آخر في الفلسفة الهيلينستيّة يُدعى دايفد سيدلي (David Sedley) إلى أنّ رموزًا مثل عضو مجلس الشيوخ ثراسيا بايتوس (Thrasea Paetus) وهيلفيديوس بريسكوس أظهروا اهتمامًا ضئيلًا في إحداث تغيير فعلي في مسار الأشياء وكانوا يُراودون ميتة بطوليّة من خلال ممارستهم حريّة تعبير جامحة ضد الإمبراطور. لقد نجح الاثنان؛ فقد رأينا سابقًا ما حدث لبريسكوس، كما قُتل بايتوس أيضًا بأمر من نيرون.
بالطبع يخبرنا سيدلي أنّ ماركوس يونيوس بروتس -واحد من أشهر المغتالين السياسيين في التاريخ- قد استبعد عمدًا أصدقاءه الرواقيين من المؤامرة على يوليوس قيصر، لأنّه فهم أنّه بالنسبة لرواقيّ فالنظام السياسي الذي يعيش المرء تحته -متضمنًا الطغيان- هو مجرد تفضيل غير عابئ. الرواقيّ الجيّد سيكون دومًا قادرًا على ممارسة الفضيلة وأن يكون إنسانًا صالحًا بغض النظر عن الظروف الخارجية، بما في ذلك تلك الظروف النظاميّة سياسيًا.
يجدر بهذه أن تكون مشكلة جديّة للرواقيين المعاصرين كما أشار هايس في مقالته المذكورة في وقت سابق. رغم كون الرواقيين يسعون جاهدين ليكونوا أفضل كائن بشري بوسعهم كونه، وأنّهم بالتأكيد يعيشون طبقًا لأخلاقيات العدل والقسط تجاه الآخرين؛ إلا أنّ الفلسفة الرواقيّة تبدو وكأنّها لا تمتلك الأدوات المكمِّلة لهذا التركيز على الفرد الصالح بنظرة عن كيفيّة تصوّر مجتمع صالح.
اعترف بعض الفلاسفة أنّ الفرديّ والسياسي ينبغي اقترانهما
المحاولات المعاصرة لتحديث الرواقيّة لتناسب القرن الواحد والعشرين (مُشتملة على محاولتي الشخصيّة) لم تأخذ في اعتبارها ببساطة مسألة الفلسفة السياسيّة بجديّة كافية، إذا كانت وضعتها في الاعتبار أصلًا. ربما يكون هذا حكمًا غير عادل؛ ففلسفات الحياة -مثل الأديان- تُعنى بشكل أساسي بالتحسّن الفردي (أو الخلاص). لا نسمع نقدًا عادة للمسيحيّة مثلًا أو البوذيّة بناءً على افتقارهما لبرنامج سياسي، هذا ببساطة ليس مقصدهما.
لكن بعض الفلاسفة اعترفوا أنّ الفرديّ والسياسيّ ينبغي اقترانهما. كان هذا مكمن عبقريّة جمهورية أفلاطون؛ على الرغم من صعوبة تنفيذ رؤيته التفصيليّة، وربما كون تنفيذها غير محبّذ. كان سيسرو -وهو فيلسوف آخر مهتمّ كثيرًا بالجانب السياسي- أيضًا صديقًا للسيناتور الرواقيّ كاتو الأصغر وقد عبّر عن استيائه بخصوص افتقار صديقه التام للحس العملي في خطابٍ لصديقه أتيكس (Atticus):
بالنسبة لصديقنا كاتو، فلن تحبّه أكثر مما أفعل أنا؛ لكن في نهاية الأمر -وبنوايا حسنة وصراحة شديدة- فإنه أحيانًا ما يؤذي الجمهورية. إنّه يتحدّث ويصوّت كأنّه في جمهورية أفلاطون، وليس في نُفاية رومولوس.
نحن أيضًا لا نعيش في جمهوريّة أفلاطون -بمعنى المجتمع المثالي- بل في شيء أكثر تشابهًا مع نُفاية رومولوس. ليس من الكافي تعلُّم كيفيّة النجاة في هذه النٌفاية؛ نحتاج إلى التفكير مليًا في كيفيّة تحويلها إلى مكان عادل صالح لمعيشة الجميع.[1]


