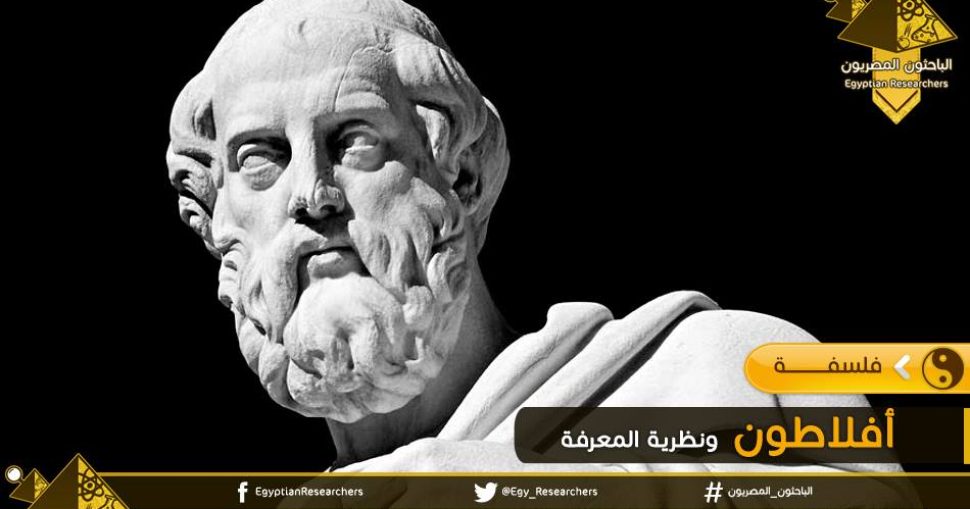يقول برتراند راسل في بداية الفصل الخاص بـ “نظرية المعرفة” عند أفلاطون:
«معظم المحدثين يسلمون بأنّ المعرفة التجريبية معتمدة على الادراك الحسي ومستمدة منه، لكن هنالك رأيًا يختلف عن هذا كل الاختلاف، تجده عند أفلاطون وغيره من فلاسفة مدارس معينة أخرى، إذ يرى هؤلاء أنّ ليس هنالك ما هو جدير باسم “معرفة” ما يمكن استقصاؤه من الحواس، وأنّ المعرفة الحقيقية الوحيدة هي التي تتصل بالمدركات العقلية، ففي رأي أفلاطون أنّ (2+2=4) فهذه معرفة حقيقية، أما عبارة كهذه (الثلج أبيض) ففيها من الغموض وعدم اليقين ما لا يجعل لها محلاً بين مجموعة الحقائق التي يعرفها الفيلسوف»
قبل الدخول في معمعة الكلام عن “نظرية المعرفة” عند أفلاطون، لا بد من إلقاء الضوء على هذه الفقرة المقتبسة من كلام “برتراند راسل” لأنّها تساعدنا كثيرًا في فهم موضوع مقالتنا.
كيف تكتسب عملية المعرفة؟
وما هي المعرفة التجريبية التي عناها راسل ومن هم أبرز القائلين بها؟
وما هو المذهب العقلي وأبرز القائلين به؟
تُكتسب عملية المعرفة بإقامة العلاقات بين عملية الفهم الداخلية من ناحية، وبين حقائق العالم الخارجي المشترك بيننا جميعًا. فهناك مصدر واحد فقط لمعرفة حقائق العالم الخارجي، هذا المصدر هو الانطباعات التي تصنعها على العقل من خلال الحواس، ولكن انعدام الثقة في الحواس ظل قائمًا منذ أيام الإغريق هو أحد مواضيع الفلسفة الشائعة، لأنه بطبيعة الحال إذا كانت نفس الأشياء ونفس المواضيع في العالم الخارجي تصنع انطباعات مختلفة على عقول الناس فما هو مكان العلم؟ ولو أننا وثقنا بالانطباعات الحسية الفردية سنواجه حتمًا بموقف قديم عبر عنه بروتاجوراس بقوله: «ما يبدو لي هو كذلك بالنسبة لي، وما يبدو لي فهو كذلك بالنسبة لك»، وعندئذ ستضيع الحقيقة الموضوعية لأية قضية، فسيكون الفرد هو الحكم الفيصل. لذلك كان من أهم الموضوعات المطروحة عند الفلاسفة الأوائل هو التأكيد على أهمية وجود أساس حقيقي وثابت مستقلاً عن أحكام الفرد، بحيث يصلح أنْ تؤسس عليه المعرفة الموضوعية.
كان طالس الملطي هو أول من أكد على أهمية وجود أساس من الحقائق، ثم جاء أفلاطون في محاورة “تياتيتوس” فقال إنه «لابد لنا أنْ نميز بين ما يدركه العقل عن طريق الحواس، وما يفهمه من نفسه بالتفكير، فالمفاهيم أمثال العدد والكمية، والتماثل والتباين، والتشابه والاختلاف، والحسن والسيء، والصواب والخطأ. لا تدخل عقولنا عن طريق الحواس ولكنها تكمن دائمًا في عقولنا». ولأنّ أمثال هذه المفاهيم تزودنا بالعناصر الأساسية لكل المعارف الصادقة، فإننا نستنتج أنها لا تأتي عن طريق حواسنا، بل عن طريق الأحكام التي تصدرها عقولنا “على الحواس”.
إن ما يقصده أفلاطون، أنّ العقل البشري مزود منذ الولادة بمجموعة من الصور أو المُثُل التي توجد فيه مستقلة عن مواضيع العالم الخارجي، وهذه المواضيع تصلح كمادة خام لطبع الصور بحيث يكون كل شيء أشبه بنقطة التقاء أو تجمع لعدد من الصور، فمثلاً إذا ما قلنا “كرة حمراء حجرية”، فسنعني كتلة من هذه المادة الخام وقد طبع عليها طابع الاحمرار والتكور والتحجر، فنحن إذن نؤمن بأنّ هذه الكتلة المعينة من المادة تلتقي مع هذه “الصور الثلاث”، فالرؤية المعينة في ضوء مختلف قد تجعل الشيء في لون آخر غير الأحمر، وإذا قورنت بكرة أخرى فقد يثبت أنها ليست متكورة، وإذا ما خبطناها بمطرقة فربما نجد أنها ليست من الحجر أساسًا. فعلى مثل هذه الأسس آمن أفلاطون بأننا نمتلك معرفة أكيدة ومحددة عن “الصور” وعلاقاتها فقط، ومعرفتنا بمواضيع العالم الخارجي تتألف في أحسن الظروف من انطباعات زائلة، أو بعبارة أكثر دقة تتفق ونظرية أفلاطون عن المعرفة؛ فالمُثُل التي تستقر أبديًا في عقولنا، لها الأفضلية على التصورات التي صنعتها الأشياء المدركة حسيًا مؤقتًا.
كانت هذه المُثُل عند أفلاطون أفكارًا عن الكيفيات أو الخواص، وافترض أنها فطرية في عقولنا، كما لو كانت “ذكريات” حملناها من وجود سابق، بيد أنّ الأمر يختلف عن الأفكار عند “ديكارت” فالأفكار عنده تعبر عن حقائق أو قضايا، ولقد حسبها ديكارت أيضًا أنها “فطرية” ولكن على نحو يخالف فيه أفلاطون، فالعقل لم يولد وهذه الأفكار بداخله، غير أنه كان باستعداد لتحصيلها بمجرد اتصاله بالعالم الخارجي، فيقول ديكارت في هذا السياق «لقد سميتها فطرية بنفس المعنى الذي نقول به إنّ الكرم فطري في بعض العائلات، وإنّ بعض الأمراض كالنقرس فيرى غيرها، ولا يعني هذا أنّ أبناء تلك العائلات يعانون من تلك الأمراض في أرحام أمهاتهم، بل إنهم يولدون بميل أو استعداد للإصابة بها»، ثم جاء بعد ذلك “ليبتنز” لينكر هذا، محتجًا بأنه إذا اتبعنا هذا المعنى، فالأفكار كلها كامنة، ولكنها لا تبلغ مرحلة التفكير الفعلي إلا عندما تتطور بنمو المعرفة، فالعقل عند الولادة ليس ورقة بيضاء نقية، بل هو أقرب إلى أنْ يكون كتلة من خام الرخام موجود فيه بالفعل تركيب غير ظاهر من العروق، فهو الذي سيحكم الشكل الذي سيتخذه الرخام عندما ينحته المثال ويعطيه شكلاً، ثم اختلف فلاسفة آخرون بشكل أعمق مع ديكارت، لذلك انقسموا إلى معسكرين:
1. القائلون بالمذهب العقلي «The Rationalists».
وعلى رأسهم “ديكارت” و”سبينوزا” و”كانط”. وجميعهم ساق من الحجج القائلة بأنّ كل المعرفة التي تحصل بالملاحظة المباشرة للطبيعة مشكوك فيها، لأنها تأتي عن طريق الحواس، ومثل هذه المعرفة قد تكون خادعة وغامضة، ثم قام كانط بمناقشة منطقية لهذه القضية في كتابه “نقد العقل الخاص” بطريقة تذكرنا بعض الشيء بأفلاطون حين يقول بأنّ الظاهرة أو موضوع الإدراك الحسي تحتوي كلاً من المادة والصورة، فالمادة تحدث التأثير في عقل المدرك، في حين تمكننا الصورة من تصنيف الظاهرة في مجموعة أشمل. فمادة الظاهرة تأتي إلينا نتيجة لخبرة نستمدها من العالم، أو بلغة كانط تكون بعدية «a posteriori» أما الصورة هي بالفعل في عقولنا في انتظار للمادة فتأتي إلينا قبليًا «a priori» أي تسبق كل الخبرات الفعلية في العالم وتستقل عنها.
2. القائلون بالمذهب التجريبي «The Empiricists».
أما التجريبيون فقد آمنوا بأنّ المعرفة عامة تأتي من خلال التجربة المباشرة وحدها، بحيث يكون السبيل الوحيد للكشف عن حقائق الكون هو أنْ نخوض في العالم باحثين عنها. وكان أبرزهم “جون لوك” و “ديفيد هيوم”.
أما ما الذي يقصده “راسل” بمثاله في عبارة (الثلج أبيض) ففيها من الغموض وعدم اليقين لدى أفلاطون.
في محاورة “تياتيوس” يستنتج أفلاطون أنّ اللون لا يكمن في عيوننا ولا في الشيء الخارجي المدرك. فلو مثلاً قلنا “ثلج أبيض” أو “زهرة حمراء”، فإنّ الفيلسوف هنا سيمحو من المناقشة كل العوامل ما عدا “الزهرة- الثلج” والعقل الذي يدركها حسيًا لأنهما وحدهما هما جوهر المشكلة، ففي إمكان الفيلسوف أنْ يحتج بأنّ الزهرة قد تبدو لأحد العقول حمراء داكنة أو فاتحة أو قرمزية، وعلى ذلك فاللون لا يكمن في الزهرة وأنه قابع في عقل المدرك، غير أنّ “العالِم” له عوامل أخرى تدخل في الاعتبار، فالضوء الذي ينير الزهرة له أهمية خاصة، فالصفة “أحمر” في وصف “العلم” -أي وصف غير وصف الفلسفة له- عند وصف الضوء يمتلك صفات موضوعية محددة، يمكن تحديدها بمعرفة عدد الموجات الكاملة في البوصة أو الثانية، وعندما يسقط الضوء على عين بشرية ينتج ما نصفه بأنه إحساس بالاحمرار.
أما عن “نظرية المعرفة” عند أفلاطون موضوع مقالتنا، فنجده في محاورة “تياتيتوس”، قد قسم المعرفة إلى قسمين: حسي وعقلي، وهاجم المعرفة الحسية أشد هجوم، فالمعرفة الحسية/ التجريبية عنده معرفة مؤقتة ذاتية نعرفها عن المُثُل، فهي أفضل قليلاً من الجهل، لكنها لا تشبه المعرفة الحقة، فالعقل هو وسيلة المعرفة الحقة. لكن ما طبيعة هذه المعرفة؟ أحيانًا ما تكون معرفة برهانية، وأحيانًا ما تكون إدراكًا مباشرًا أو حدسيًا لموضعات الادراك. ثم تجده يربط في هذه المحاورة بين المعرفة والوجود، فالأولى تعتمد على الثانية. فعضو الحس حينما يتفاعل مع الموضوع المحس يضطرب، وهذا بناء على مذهب هيراقليطس متغير أبدًا، فيتغير بتغير الصورة الحسية المدركة، فيلاحظ سقراط أنه وهو معافى يجد النبيذ طعمه حلوا؛ بينما يجده مُرًا وهو عليل، أما حينما تكون على اتصال مع المُثل العقلية، فإنها تصل إلى حالة المعرفة اليقينية.
أما عن موضوعية المعرفة وهو يعتبر جوهر نظرية المعرفة عند أفلاطون فمنطوقه هكذا، ما هو موجود وجودًا مطلقًا يمكن أنْ يعرف معرفة كاملة، وما ليس بذي وجود على الإطلاق لا يمكن أنْ يعرف مطلقًا. فخصائص موضوع المعرفة هي التي تحدد إمكان معرفته وخصائص هذه المعرفة. ولما كانت الأشياء موجودة أكمل ما يكون الوجود، فإنه من الطبيعي أنْ تكون معرفتها معرفة يقينية. لكن ماذا سيكون مصير المعرفة الحسية/ التجريبية هنا عند أفلاطون؟ يجب هنا الرجوع إلى مكانة عالم الحس عند أفلاطون، ربما نجده في “تشبيه الكهف” يحتل مكانًا وسطًا بين الوجود الخالص والعدم الخالص، وعليه سيكون مصير المعرفة الحسية لاهي بالجهل الخالص ولا باليقين الخالص، بل هي مؤقتة وهذا هو شأن المعرفة الظنية؛ فيذهب “تياتيتوس” وهو تجريبي محنك، إلى أنّ الإدراك البشري في النهاية لابد أنّ يكون وحده مصدر المعرفة، غير أنّ سقراط يهاجم هذا الرأي أو هذه النظرة؛ إذ لو كان الأمر كذلك، فلا بد أنْ تكون جميع الأوهام الحسية كالسراب والأحلام “معرفة “.
ماهي طبيعة المعرفة اليقينية؟
رأينا من قبل أنّ المعرفة عند أفلاطون قسمين، حسي وعقلي. وهذا الأخير هو أيضًا جزأين:
1. جزء يمثل المفاهيم الرياضية.
2. وجزء يمثل الأشياء في ذاتها أو المُثُل. ونفس الشيء، لطالما كان لدينا فيما يخص المعقولات نوعان من الموضوعات، فإنه من الطبيعي أنْ يكون لدينا وطبقًا لمبدأ موضوعية المعرفة، نوعان مقابلان من المعرفة: معرفة رياضية ومعرفة فلسفية. والفرق بينهما:
1. أن المعرفة الرياضية تضطر إلى استخدام أشكال محسوسة على الأقل كمساعد لها في براهينها. بينما المعرفة الفلسفية لا تلجأ إلى المحسوس بتاتًا.
2. المعرفة الرياضية تبدأ من فروض لتنتهي إلى نتائج. أما الفلسفية فتنتهي إلى مبدأ أول مطلق لا يفترض شيئًا بل يفترضه كل شيء.
فمنهج دارسي الرياضيات أو الهندسة فينطلقون من مفاهيم المربع والدائرة والأعداد الزوجية والفردية وما إلى ذلك، ولا يقفون أمام تبرير هذه المفاهيم، بل هي واضحة بذاتها لا تحتاج إلى مبدأ ترجع إليه، والمعرفة الرياضية عند أفلاطون ليست أعلى المعارف، بل تدخل ضمن المعارف العقلية وتمهد لمعرفة الديالكتيك. أما المعرفة الفلسفية فأداتها الوحيدة هي العقل، فتظل تنتقل من “مثال” عقلي إلى آخر حتى تصل إلى المبدأ المطلق الكلي لكل وجود وحقيقة. والمنهج الذي تستخدمه المعرفة الفلسفية هو الديالكتيك أي الجدل العقلي وهو أوثق المعارف وأكثرها يقينًا، ولهذا المنهج طريقان: جدل صاعد، وجدل هابط .
كيف نكتسب الأفكار الخاطئة؟
قلنا أنّ أفلاطون كان فيلسوفًا عقلانيًا؛ أي يؤمن بأنّ أفضل معرفة وأعظمها دوامًا لا بد وأنْ تحصل عن طريق الذهن. لكن كانت إحدى المشكلات التي كان يواجهها الفلاسفة العقليون هي، كيف تعرف أنّ لديك أفكارًا صادقة؟ في هذا الموقف لدى الفلاسفة التجريبيون الفرصة لمراجعة أفكارهم عن العالم المادي؛ فإذا لم تكن على يقين تام- وأنت تجريبي- بأنّ لطائر البطريق أرجلاً ففي مستطاعك أنْ تعيد النظر إليه مرة أخرى. أما إنْ كنت عقلانيًا؛ فإنه يجب عليك بداهة أنْ تثق في أفكار الوضوح العقلي- المقلقة إلى حد ما- وعلى الانسجام الجمالي والتماسك المنطقي، غير أنّ أفلاطون كان قلقًا حقًا حول كيف يقع أشد الفلاسفة تسمكًا بالضمير في أخطاء خطيرة؟ كان جواب أفلاطون هو أنّ المعتقدات الخاطئة تسببها في العادة أوهام الذاكرة وتقلباتها؛ فذاكراتنا تشبه لوحة من الشمع مليئة بالانطباعات المنقوش عليها بواسطة الخبرات والأفكار الماضية، ونحن في بعض الأحيان نطبق هذه الأفكار أو الذكريات بطريقة غير مناسبة على الخبرات الماضية وهكذا نقع في الأخطاء.
ظلت أكاديمية أفلاطون حية قرابة الألف عام حتى أغلقها في النهاية الإمبراطور “جوستنيان” عام 529ميلادية. وكان الأفلاطونيون المحدثون من أمثال ” أوريجين” و”أفلوطين” قد عدلوا كثيرًا من أفكار أفلاطون عن الخير والنفس والخلود وحولوها إلى لاهوت، وقد ظلت نصوص أفلاطون باقية يشرحها الفلاسفة الشرقيون كابن سينا والرازي الطبيب ،وبفضلهم أُعيد اكتشافه مرة أخرى في عصر النهضة الإيطالي وتأثر به كل من بترارك وأرازموس، وتوماس مور، وأعجب جاليليو أول عالم طبيعي حديث بمحاورة “طيماوس” التي دعمت وجهة نظر معادية لأرسطو. وادعت كل حقبة في تاريخ الفلسفة الأوروبية أنّ لها أفلاطونها الخاص بها.
شوبنهور: «الوظيفة التربوية للفن هي أنْ تجعل المُثل الأفلاطونية ملموسة وفي متناول أيدينا».
هيجل: «أنا أرى نسخة مبكرة من فلسفتي الجدلية في مثالية أفلاطون».
هيدجر: «فلسفتي الخاصة هي أنْ أعيد اكتشاف “الوجود” الذي أخفته مثالية أفلاطون».
وايتهد: «الفلسفة الغربية كلها هي حواشي على فلسفة أفلاطون».
صورة أفلاطون في العالم الإسلامي
أما أفلاطون فقد عرفه المسلمون معرفة طيبة ووصلت آراؤه إليهم، غير أنه من المحتمل ألا يكون هناك ترجمة كاملة لكتبه، ويعلق على هذا سامي علي النشار فيقول: «لعل أسلوب الحوار الذي اصطنعه أفلاطون لم يصادف هوى مترجمي كتبه ». لكن لا شك أنّ له ملخصات طيبة لكتبه، وبخاصة ملخصات جالينوس. وقد ذهب الباحثون أول الأمر إلى أنّ الإسلاميين لم يعنوا بأفلاطون ولم يتأثروا به قدر تأثرهم بأرسطو، غير أنّ هذا تعميم في الحكم لأنه إذا كانت المدرسة الفلسفية الإسلامية مشائية- أرسطية في جملتها، إلا أنها كانت مشوبة بعناصر أفلاطونية محدثة، ولكن هناك مدرسة فلسفية أخرى كانت أفلاطونية وهي مدرسة أبى بكر الرازي، وبعد أنْ نُشرت رسائل الكندي بدى أنه كان أفلاطونيًا في ميتافيزيقاه أكثر منه أرسطوطاليسيًا، بل إنّ الكثير من آراء الفارابي وابن سينا أفلاطونية لاسيما في رسائله الصغيرة وكثير من مباحثه في الإشارات. ومعروف أنّ الفارابي كان قد قام بمحاولة “الجمع بين رأيي الحكيمين” أفلاطون وأرسطو، بيد أنّ تأثيره الأكبر كان في دوائر المتكلمين، وقد سرت نظرياته في الحب في كتاب “الزهرة” لابن داوود، وكتاب “طوق الحمامة” لابن حزم، وأثره واضح بيّن في المدرسة الصوفية والإشراقية أو أصحاب وحدة الوجود. أما عن سبب تأثر المسلمون به لاسيما المتكلمون منهم؟ لأنهم اعتقدوا أنّ أفلاطون قد نادى بخلق العالم.