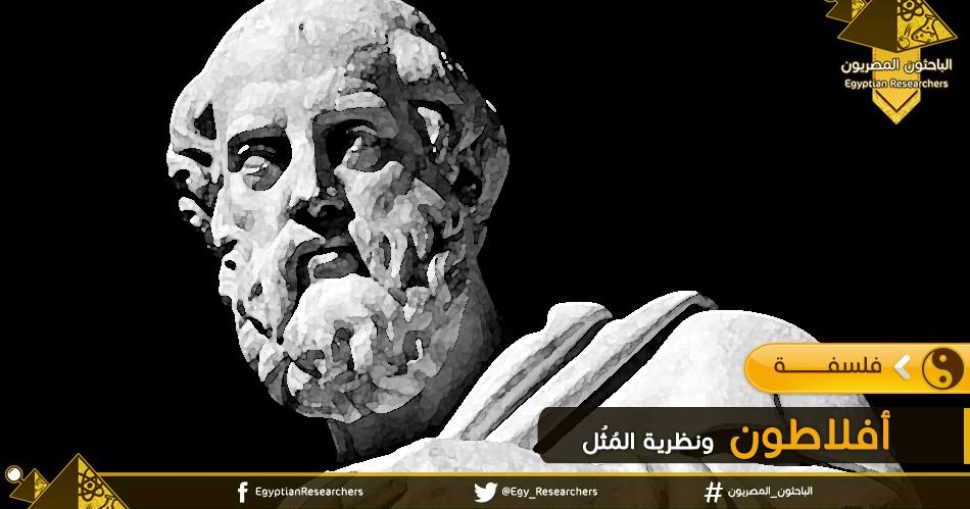يحاول أفلاطون في منتصف رائعته «الجمهورية» وضع تعريف للفلسفة بشرح كلمة «φιλοσοφία -فيلوسوفيا» والتي تعني (حب الحكمة)، غير أنّ تعريفها هذا يشوبه شيء من الغموض، لذا كان مطروح عليه هو الدفع بأنّ الفيلسوف هو الشخص الذي يحب صنوف الحكمة كلها لا بعضها، لكن هذا التعريف لا يزال على قدر غير كاف من الدقة، لأنه يشمل أولئك الذين لا يحسنون تمييز الأشياء، فالفلاسفة الحقيقيون هم إذن من افتتنوا بمشهد الحقيقة في ذاتها. وهذا يعني أنهم لا يهتمون بالأشياء الحقيقية والجميلة فحسب، بل بالحقيقة والجمال في ذاتهما. ولتوضيح هذه الفكرة يُقدم أفلاطون شرحًا لنظريته عن المُثُل.
تخيل هناك جمع من الناس به بعض فلاسفة قلائل يحضرون احتفالات ديونيسيوس، هنا قد تجد محبي الفنون البصرية والسميعة تسرهم النغمات والألوان والأشكال الجميلة وكل صنوع الإبداع الفني الباقية في الحفل، ولكن هؤلاء بفكرهم لا يستطيعون الاستمتاع بالجمال ذاته. وأمثال هؤلاء -شأنهم في ذلك شأن السواد الأعظم من الناس- «يؤمنون بالأشياء الجميلة، ولكن لا يؤمنون بالجمال في حد ذاته، ولا يمكنهم فهم من يحاول إرشادهم إلى معرفته». ويقول أفلاطون أنّ غير الفلاسفة هنا يعيشون في حالة أشبه بالحلم، لأنهم يخلطون بين الأشباح المتحركة (أي الأشياء الجميلة) وهؤلاء لا يكون لديهم إلا رأيًا، وبين الواقع (الجمال في ذاته) وهؤلاء لديهم المعرفة، والفلاسفة الحقيقيون هم من أفاقوا من هذا الحلم؛ فهم يدركون أنّ ثمة عالمًا مثاليًا قوامه “المُثُل”، تأتي منه النسخ غير المثالية أو الصور غير الأصلية التي تتمثل أمامنا بعيدًا عن العالم المادي وآراءنا الذاتية. فما الفرق بين الرأي والمعرفة إذن؟
إنّ مَنْ تكون لديه معرفة، تكون لديه معرفة بشيء ما، أي لديه معرفة بشيء موجود لأنّ ما ليس بموجود هو عدم، وعلى ذلك تكون المعرفة ثابتة غير قابلة للخطأ، والمعرفة خاصة بعالم أزلي إدراكه فوق متناول الحواس. أما عن الرأي ربما هي المعرفة التجريبية التي نكتسبها من الحياة اليومية التي تتكون لدينا عن العالم المادي والتي نكتسبها عن طريق الحواس. ويعتقد أفلاطون أنّ هذا النوع من المعرفة مفيدة إلى سواد الناس، غير أنها ليست بالمعرفة الحقة، فأفلاطون في ذلك مثله مثل الفيثاغوريين وهيراقليطس وربما سقراط يذهبون إلى أنّ هذا النوع من المعرفة أو الرأي ضربًا من الوهم، أو قناع يخفي في طياته الحقيقة الواقعية.
الكليات والجزئيات
العالم الذي نراه من حولنا مليء بـ “الجزئيات” أو الأمثلة الفردية للأشياء الزراف، القطط، النوافذ، السيارات، إلــخ… وهذه الأمثلة الفردية لا يمكن أنْ توجد إلا في زمان محدد ومكان معين، فإذا ما قلنا مثلاً إنّ “الزرافة لوسي” تعيش في حديقة الحيوان بالجيزة، فهذا يعني أننا نقصد بلفظة “الزرافة لوسي” بفرد من الزراف الجزئي الذي ينتمي بدوره إلى فئة كلية تدعى الزراف. فإذا ما فتحنا أي قاموس وبحثنا عن لفظة “زراف”؛ فإننا نصل إلى تعريف لهذه الكليات أو الفئات بما هو مشترك بين جميع الزراف من طبيعة عامة، وهذه الطبيعة العامة لا تولد مع ولادة “الزرافة لوسي” الجزئية الكائنة بحديقة الحيوان بالجيزة، ولا تموت بموتها، بل الواقع أنّ هذه الطبيعة العامة لا تشغل حيزًا من المكان أو الزمان، بل إنها أبدية.
عالم “المُثُل” المُحيّر
عالم النماذج الأصلية أو المُثُل، يمسى عادة عالم أفلاطون المثالي عالم “الصور”، أو بطريقة أكثر غموضًا عالم «المثل- Ideas» أو «الأفكار»، فعالم المُثُل أو الصور عنده عالم أزلي غير متغير، إنها الأنماط ثابتة لجزئيات أشد تواضعًا هي المألوفة في عالمنا، كذلك تترتب المُثُل ترتيبًا تصاعديًا في نوع ما من البنية، فإذا ما قلنا مثال “المقعد أو الكرسي” فهو تافه أو أدنى نسبيًا من حيث الأهمية، في حين أنّ مثال “المجتمع العادل” بالغ الأهمية ويقترب من القمة. وهنا يقول برتراند راسل: «يقول أفلاطون إنك حيث وجدت عددًا من الأفراد تشترك في اسم مشترك، كان لهذه الأفراد “مثال” مشترك أيضًا، أو “صورة” مشتركة». فمثلاً على الرغم من أنّ هنالك أسرّة كثيرة، فهنالك “مثال” واحد للسرير أو “صورة” واحدة له؛ وكما أنّ انعكاس السرير في المرآة مظهر فقط وليس “بالحقيقي” فكذلك الأسرّة الجزئية الكثيرة ليست حقيقية، إذ هي ليست سوى نُسخ من “المثال” الذي هو السرير الحقيقي الوحيد.
لكن لماذا احتاج أفلاطون إلى “الصور”؟
سبق وأنْ عرفنا أنّ كثيرًا من فلاسفة اليونان قد أعجبوا بنظرية هيراقليطس في التدفق المستمر للعالم المادي الذي لا ثقة فيه وغالبًا ما كان يقول إنّ من العبث السعي وراء معرفة في العالم التجريبي، وإحدى الاستجابات لفلسفته تعني أنّ أية معرفة غير ممكنة وهذه هي وجهة نظر الشكاك والذي كان أفلاطون مناوئ لهم، غير أنّ الفيثاغوريين برهنوا على أنّ المعرفة الرياضية تكمن خلف هذا العالم المادي؛ فكان الحل الذي قدمه أفلاطون هو اقترحه بوجود عالم “بديل” من الأفكار التي لا يمكن أنْ تتغير، وأنه في هذا العالم فقط تكمن “المعرفة الحقة”.
في استطاعتك أنْ ترسم نسخة دنيا من الدائرة بأنْ ترسم دائرة من الرمال، لكن “الدائرية” نفسها هي تصور “مثالي” يستطيع الذهن وحده أنْ يدركه. وفي مقدورك أنْ تشتري ست بيضات، لكنك لا تستطيع أبدًا أنْ تجد العدد “6” إلا في الذهن. فميز أفلاطون بين عالم العقل وعالم الحواس، ثم عقب على ذلك بقسمة كل من العقل والإدراك الحسي إلى نوعين، أما نوع العقل فيسميهما على التوالي “العقل الخالص” و”قوة الفهم”، فأما العقل الخالص فهو أعلى النوعين وما يعنيه هو الأفكار الخالصة وطريقته هي “الديالكتيك” أو الجدل. ثم يحاول أفلاطون أنْ يفرق بين الرؤية العقلية الواضحة وبين رؤية الإدراك الحسي المشوهة، وهنا ينتهي بنا إلى التشبيه المشهور بتشبيه الكهف، ويسميه بعض الناس بأسطورة الكهف وهي تسمية مغلوطة، فيقول أفلاطون إنه يمكننا أنْ نتصور كهفًا تحت الأرض له فتحة إلى الخارج، ويعيش رجال في جوفه مقيدة سيقانهم والرقاب منذ كانوا أطفالاً، وقيودهم هذه تمنعهم عن الحركة وعن النظر إلا إلى الأمام، وتضيء الكهف نار قائمة على مكان مرتفع بعيدًا خلف المسجونين، ويقوم بينها وبينهم طريق مرتفع عليه يقوم حائط صغير يشبه الحاجز، فكل ما يرونه عليه هو ظلالهم هم وظلال الأشياء الكائنة ورائهم والتي تلقيها النار بضوئها على الجدار، فلا مناص من أنْ يعدوا هذه الظلال كائنات حقيقية دونما أنْ تكون لديهم فكرة عن الأشياء التي ألقت أمامهم هذه الظلال، إلى أنْ خرج أحدهم فاستطاع أنْ يرى الأشياء الحقيقية لأول مرة- إلى أخر التشبيه- فهكذا نجد داخل الكهف: أ- ظلال. ب- تماثل الأشياء. ج- النار. أما خارج الكهف فهناك الحقيقة. فداخل الكهف “العلم الحسي”، وخارجه “العالم العقلي”.
التعريفات السقراطية
جعل أفلاطون سقراط ينطق بتعريفات بأنْ «الأشياء لا تتفاوت بتفاوت الأشخاص؛ بل يجب أنْ يكون لها جوهرها المناسب و الثابت؛ فهي لا ترتبط بنا ولا تأثير لنا عليها، ولا تتغير تبعًا لخيالنا ولكنها مستقلة». أو بعبارة أخرى فإن تلك “المُثُل” تضع معايير ثابتة من جهة، وتبين خطأ “النسبية” لدى السفسطائيين من جهة أخرى. فعندما سأل سقراط عن “الشجاعة” مثلاً، لم يكن بطبيعة الحال يريد قائمة من الأمثلة للأفعال الشجاعة؛ بل تعريفًا للشجاعة ذاتها. ويشرح أفلاطون كيف يمكن الوصول إلى تعريفات كاملة؛ فهو يقيم تفرقة واضحة بين جميع الجزئيات الدنيوية التي هي الجمال وفكرة الجمال ذاتها؛ فيوجد “الجمال ذاته” منفصلاً عن الأشياء الجميلة وهي وحدها التي نعرفها على أنها “جميلة” لأنّ لدينا إدراكًا غامضًا لمثال الجمال.
نقد أفلاطون لنظرية المُثُل
لقد تحقق لأفلاطون نفسه في النهاية أنّ هناك مشكلات كبرى تواجه نظريته، وقد ذكر ذلك في محاورة “بارمنيدس”- ويراجع أفلاطون فيها فكرة الاتصال بين العالم المعقول والعالم المحسوس، والمشاركة بين المحسوسات وبين المُثُل أو الصور، لكنها تبدو أنها كانت محاولة للرد على خلفاء بارمنيدس الذين يرفضون اثبات أي علاقة بين العالم المعقول والعالم المحسوس-، وهذا ما جعل بعض الباحثين يعتقدون أنّ أفلاطون قد تخلى عن نظريته في “المُثُل” تمامًا، وتتركز المشكلات كلها حول العلاقة المحيرة بين “المُثُل” و”الجزئيات” فهل الفرد يشارك في المثال كله أو في جزء منه فقط؟ فلو كانت الجزئيات تشبه المُثُل لكان هناك شيء مشترك بينهما شيء ربما يعرضه “مثال” آخر، وإذا كانت هذه المثل الثلاثة بينهما شيء مشترك فسوف يكون هناك “مثال” آخر، وهكذا إلى مالا نهاية. ومن نافلة القول هنا أنْ نقول أنّ حجة الإنسان الثالث هي مثال لما أسماه الفلاسفة بالتقهقر اللامتناهي فهي لا تبرهن على أنّ نظرية “المُثُل” خاطئة، بل فقط على أنها تشير إلى شيء بالغ الغرابة. وهذه الحجة ساقها في الأساس “أرسطو” ضد نظرية المثل، ومن ناحية أخرى سوف تطبق الفكرة من جديد؛ أي لابد من وجود تشابه رابع وهكذا إلى مالا نهاية، لكن كانت هنالك مشكلات أبعد من هذه قد تحقق أفلاطون منها أنّ الجزئيات تشارك في المثل بطريقة ما، ومن ثم أقر بما امتلكنا جميعًا جانبًا من المثال، وهذا يعني أنّ المثال واحد وكثير في آن معًا، وهذا أمر غير منطقي تمامًا، ولم يكن أفلاطون متأكد من وجود مُثُل للإنسان أم لا، ولو أنّ “المُثُل” أزلية لا تتغير؛ فلا بد هناك مثال لأشياء لم نخترعها بعد، كالحديث مثلاً عن السيارات الطائرة، وإذا ما كان جميع ما في العالم من جزئيات هي نسخ من المُثُل، إذن ربما كان لا بد أنْ يكون هناك مُثُل للقذارة والوحل والكوليرا والحروب وما إلى ذلك؟
مشكلة الكليات هي من الأمور المحيرة والتي يجهلها معظم الناس، بل إنها أقلقت الفلاسفة باستمرار، فما هي الطريقة التي من الممكن أنْ نعرف بها “الكليات”؟ وكيف توجد بالضبط؟
وما نوع الحقيقة الواقعية التي تمتلكها؟ ومَن الذي يستطيع أنْ يخبرنا بها؟ إلخ.
حاول أفلاطون أنْ يجب عن هذه الأمثلة، غير أنه لم يوفق. لقد أراد أفلاطون بإلحاح يائس أنْ يقوم بتأسيس مذهبًا فلسفيًا منيعًا لا يمكن مهاجمته. وأنْ يصمد للأبد أمام شكوك السفسطائيين المدمرة للأخلاق وللسياسة- حسب اعتقاد أفلاطون-، ولقد ظنّ أفلاطون أنه بابتكار هذه النظرية أصبح من الممكن إقامة بُنى خلقية وسياسية راسخة في جمهوريته.
غير أنك واجد ميزات عظيمة لهذه النظرية، فإنها تزودنا بإجابات دقيقة ورائعة عن كثير من الأسئلة الفلسفية المختلفة؛ فإنها تفسر لِمَ الأشياء تبدوا على نحو ما هي عليه، وتوضح المُثُل ما الفرق بين المعرفة الحقة والاعتقاد؟ وكيف نستطيع الوصول إليها عن طريق العقل وحده. إنها تفسر لنا كيف نكون قادرين على إصدار أحكام القيمة من كل نوع، فنحن نعرف “الطاولة الجيدة” مثلاً عندما نقترب من “مثال” الطاولة، وإنها تفسر لنا ما هو حقيقي.