مقدمة
ظهرت الفلسفة اليونانية في بداية القرن السادس قبل الميلاد، على يد حكماء مدينة «ملطية»، الواقعة على شاطئ آسيا الصغرى. وقد جرى العرف على اعتبار طاليس (624-546 ق.م) أول الفلاسفة، ثم تبعه في ذلك تلميذه أنكسيمندريس (610-547 ق.م)، فتَحوَّلت طريقتهم لتفسير العالم إلى نشاط جديد مختلف عن الأسطورة والدين معًا، فصار نشاطًا يُعرف على يد الفيلسوف والرياضي ڤيثاغورس بمحبة الحكمة؛ أيْ الفلسفة (philosophy). وإنه لمن الصعب تحديد سببٍ معين لظهور الفلسفة كتيار فكري جديد شَكَّلَ نوعًا من الثورة العقلية على التفكير الاجتماعي السائد في اليونان، وفي العالم القديم وقتها. لكن التقليد الفلسفي اللاحق قَدَّم تفسيرًا محددًا لتلك المحاولات الفلسفية القديمة عند طاليس وأتباعه الأوائل، وهو انشغالهم بتحديد «المادة الأولى» التي انبثق منها الكون، ليأتي المأثور الفلسفي التقليدي ويقدم إجاباتهم تقديمًا متتابعًا يُظهر نوعًا من التطور والتعقيد، وصولًا إلى الأنساق الفلسفية الكبرى التي ظهرت في القرن الرابع قبل الميلاد على يد قطبي الفلسفة اليونانية أفلاطون وأرسطو.
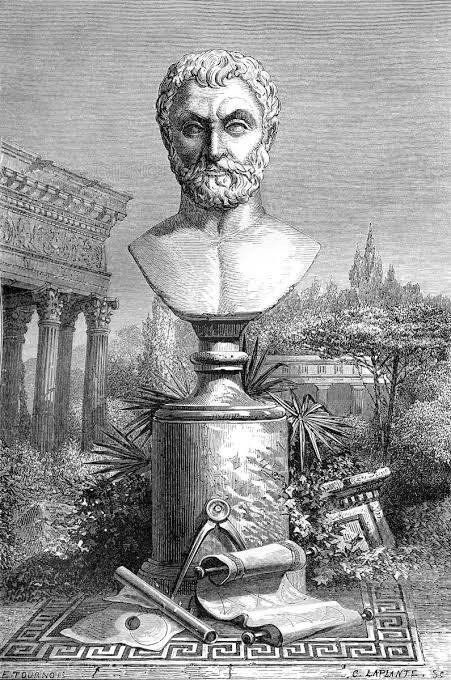
التأريخ التقليدي لبدايات الفلسفة
يُرجع طاليس أصل الكون إلى مادة واحدة هي الماء، فينتقده تلميذه أنكسيمندريس الذي يضيف مفهومًا جديدًا للفكر هو «الأبيرون»، ويعني «اللامتعين»، حيث يرفض بالحجة العقلية أن يكون الأصل عنصرًا محددًا كالماء. ثم جاء بارمنيدس (540- ؟)، فيلسوف مدينة إيليا، بتمييزه المهم بين العالم الظاهر لنا من خلال الحواس، وبين الحقيقة المنطقية المكتشفة عن طريق العقل، موضحًا أن اليد العليا في الإدراك يجب أن تكون للاستنتاجات العقلية وليس لفوضى الحواس.
أما أنبادوقليس (490-430 ق.م)، القادم من مدينة صقلية، فقد اقترح لأول مرة النظرية الشهيرة القائلة بوجود أربعة عناصر رئيسة تُشكِّل جذورًا لكل الكائنات في العالم، كما أنها خاضعة لقوتي المحبة والكراهية المتنافرتين، واللتين تعملان على تآلف وانحلال العناصر الأربعة في العالم. وهو بمحاولته تلك فصل، ولأول مرة، بين المادة (العناصر الأربعة)، والقوة الطبيعية الفاعلة (المحبة والكراهية). وتطورت الأطروحات الفلسفية عن أصل الكون أكثر مع ظهور فيلسوف أثينا الشهير أناكساغوراس (500 – 428 ق.م) صاحب مبدأ (النيوس – nous) أو العقل الكوني، الذي بعث الحركة في المادة البدائية الأولى، مُسببًا نشأة النظام الكوني، إلا أن المنظومة الأشمل في هذا التطور هي ما قدمته المدرسة الذرية القائلة بفراغٍ لا نهائي تسبح فيه ذرات مادية، غير قابلة للانحلال أو الانقسام، بحركة ذاتية دون أن يحكمها شيء غير الضرورة المادية، ومن خلال تصادماتها العرضية واختلاطها المتنوع، تَشكَّلت ظواهر العالم المرئي.

إن الخاتمة المنطقية بالنسبة إلى التأريخ الفلسفي التقليدي، هي الفكر الأفلاطوني والفكر الأرسطي، القادرين على جمع كل تلك التيارات السابقة، بعد عملية فحص ونقد عقلي، في مذاهبهم الكبرى عن الوجود والعقل والأخلاق. ورغم وجاهة هذا التأريخ التقليدي الذي يُظهر كثيرًا من الجوانب الإبداعية في الفترة المبكرة لظهور الفلسفة، فإنه يُخفي الكثير من الجوانب المهمة في تلك الفترة التأسيسية لبداية الفلسفة، بل إنه يتجاهل الدافع الأساسي لبدايات التفلسف اليوناني. وقبل أن نوضح الجوانب المُهمَلة في الفكر الفلسفي المبكر، لا بد لنا من توضيح السبب من وراء طمس معالم تلك المرحلة، وحصرها في تساؤل محدد عن «ماهية المادة الكونية». ومن المعروف أن ذلك الأسلوب في التأريخ للفترة المبكرة للفلسفة يعود إلى نصوص أرسطو. فما السبب الذى دفع أرسطو لحصر بدايات الفلسفة في تساؤل محدد عن ماهية المادة الكونية؟ وما هي الجوانب المهملة في بدايات التفكير الفلسفي؟
المنظور الأرسطي للفلاسفة الأوائل
عَرضَ أرسطو آراء مدرسة ملطية أكثر من مرة في أعماله الأساسية، خاصة في كتاب «الطبيعة»، وكتاب «في الكون والفساد»، وأيضًا في مقالاته «في ما بعد الطبيعة». وفي أبحاثه المختلفة نجد رأيه الشائع الذي ينسب إلى طاليس بداية الفكر الفلسفي ككل. إلا أن شرح أرسطو لأفكارهم لا ينفصل عن عرضه لأفكاره الفلسفية نفسها، فمن المعروف أن المذهب الأرسطي يقوم على تفرقته الشهيرة بين المادة التي يسميها «الهيولى»، وبين الصورة «الماهية»، لذلك كانت نظرته إلى التراث الفلسفي السابق عليه من خلال نافذة مقولاته الفلسفية، فصار المذهب الأرسطي وأسئلته بمكانة غربال لأفكار السابقين. وعلى هذا حُصِر فكر المدرسة الملطية، بالنسبة إلى أرسطو، في التساؤل عن «المادة الأولية للكون»، أو بلغة مذهبه التساؤل عن طبيعة الهيولى. وعلى هذا الأساس تُغوضي عن أغلب جوانب الفكر الفلسفي في مراحله المبكرة لحساب سؤال محدد هو: ما هي المادة الأولية التي انبثق منها الكون؟ إلا أن هناك سلسلة من الأسئلة والإجابات يقطعها السرد الأرسطي بين ذلك التساؤل الذي أطلقه طاليس، وبين المذهب الأرسطي الذي يمثل الذروة الفلسفية التي ينتهي عندها كل تساؤل قد طُرِح. ولهذا السبب، كان تناول أرسطو لبدايات الفلسفة على يد مدرسة ملطية عرضًا يشوبه الكثير من المذهبية. ورغم أنه صار هو السرد التاريخي الشائع كما عرضناه بإيجاز سابقًا، فإنه غيرُ كافٍ لتفسير تلك الظاهرة الفريدة التي نشأت في بلاد اليونان.

خطوة الفلسفة الأولى: التفكير في أصل الحياة وتنوعها
إن معرفتنا بالفلاسفة الأوائل، الذين عاشوا في ملطية في القرن السادس قبل الميلاد، غير دقيقة، ولا نملك عنها المصادر الوافية، فطاليس لم يترك شيئًا مكتوبًا، أما أنكسيمندريس فقد وضَعَ كتابًا تحت عنوان «في الطبيعة»، لكنه فُقِد، ما عدا شذرات قليلة ذكرها أرسطو وشُراحه. والأمر نفسه ينطبق على أنكسيمانس (588 – 524 ق.م) الذي كَتَبَ مُؤلَّفًا عن الطبيعة، وقد ضاع أيضًا.
وكما ذكرنا سابقًا، أن ما كان يبحث عنه أرسطو في أفكارهم مرتبط بمذهبه الفلسفي، وبخاصة بحثه في مسألة الهيولى أو المادة الكونية الأولى. ومن غير المنطقي أن تنشغل مدرسة ملطية بتساؤلات طرحها أرسطو في مذهبه فيما بعد. ولكي ننفذ إلى روح الفلسفة في نشأتها الأولى على يد فلاسفة ملطية لا بد أن نعود إلى ظروف واقعهم، بعيدًا عن إسقاطات اللاحقين عليه، ونحاول أن نكتشف طبيعة التساؤلات التي انشغلوا بها حقًّا.
إن بزوغ ظاهرة معقدة بحجم الفلسفة اليونانية، لا يمكن أبدًا حصرها في عامل محدد، أو ربطها بلحظة تاريخية معينة منفصلة عن المحيط الخاص بها. وعلى هذا الأساس، فقد نشأت الفلسفة على يد الأوائل، نتيجة لتلاقي عدد من العوامل التاريخية والاجتماعية التي ساهمت في تلك القفزة الفكرية الكبرى.
فأولًا، كان التأثر بالحضارات الشرقية كبيرًا، وبخاصة حضارة بابل ومصر القديمة. فقد نقل أوائل الفلاسفة، بداية من طاليس، الكثير من التقنيات العلمية المرتبطة بالرصد والحساب. ومن المعروف أن أهل بابل ومصر القديمة قد برعوا في عمليات رصد حركة الأفلاك في السماء، وتركوا سجلات ضخمة عنها، بالإضافة إلى تقدمهم الكبير في عمليات تخطيط المدن وحساب المساحات الأرضية. وبداية من القرن السابع قبل الميلاد، شهدت أغلب مدن اليونان تطورًا ملحوظًا في الفنون والصناعات، فساهمت التطورات التقنية في تقدير قيمتي الدقة والرصد، لما تحققانه من فوائد أكبر في مجالات التجارة والملاحة والزراعة، فاكتسب العقل مكانة كبرى. وقد تأثر أوائل الفلاسفة بتلك الحالة التي كانت بمكانة تفاؤل تجاه قدرة العقل الإنساني على الحساب والرصد، ومن ثم على التأمل والتنبؤ. ولم تكن الفلسفة في مراحلها الأولى إلا تبشيرًا بتلك القدرة وممارسةً لها. فطاليس يتنبأ بالخسوف الشمسي تنبؤًا دقيقًا، وأنكسيمندريس يُعد أول من اخترع المزولة الشمسية، ويُنسب إليه رسم أول خريطة جغرافية، وقد عبّر أناكساغوراس عن ذلك خير تعبير في إعلانه أن الإنسان هو أذكى الحيوانات؛ لأن له يدَينِ قادرتان على صناعة الأدوات المختلفة.
ثانيًا، مهدت الظروف الاجتماعية لليونان في ذلك الوقت، وبخاصة منطقة إيونيا ومدينتها الكبرى ملطية، القائمة على التجارة البحرية على وجه الخصوص، لخلق مساحة من الفراغ، وحب الاستطلاع الممزوج بروح المغامرة. وقد كانت تلك الروح نتيجة مباشرة لازدهار حركة التجارة والربح الوفير. فارتفعت قليلًا أعباء الحياة اليومية عن شخصياتٍ من أمثال طاليس وفيثاغوراس، وانطلقوا في رحلاتٍ استكشافية للعالم القديم، كان غرضها الوحيد هو تحصيل المعارف واكتساب الحكمة. لكن النقطة الحاسمة كانت هي «حرية التساؤل والتفكير»، التي كانت نتيجة لطبيعة النظام السياسي في اليونان وقتها، فالتنظيم السياسي المُسمى «الدولة المدينة»، وغير الخاضع لثنائية «القصر والمعبد»، قد سمح بحرية نسبية أطلقت العنان لتلك العقول الاستكشافية، دون أن تتعرض لرقابة من جانب السلطة، وبخاصة في مراحلها الأولى.
إن العقل الإنساني في تجربته الفلسفية، دائمًا ما ينطلق من نقطة مرتبطة بواقعه المباشر. ولأن أهل ملطية كانوا في الأساس تجارًا ورجالَ ملاحة، فقد انشغل العقل الفلسفي، في مراحله الأولى، بمشكلات مرتبطة بالظواهر الطبيعية، سواء كانت جوية أم فلكية كالبراكين، والرياح، والأمطار، والبرق، والخسوف، والكسوف. وأيضًا انشغلوا كثيرًا بالمظاهر الجغرافية، والتقابل بين الحياة المائية والحياة البرية. وارتقى التأمل في لحظة ما حتى أصبح يدور في فلك «أصل الحياة» ككل، فصار بمكانة تحدٍّ مستفز للعقل الفلسفي الباحث، في تلك المرحلة، عن إجابات مخالفة لما تقدمه روايات الأساطير التي لم تعد ترضي عقله.
فلسفة الطبيعة عند مدرسة ملطية
ولذلك يمكن أن نستخلص أنّ تأمل مظاهر الحياة الطبيعية كانت نقطة الانطلاق الحقيقية للفكر الفلسفي اليوناني. ولا تكمن براعة وأصالة المدرسة الملطية في تساؤلها عن «ماهية المادة الكونية» بالصياغة الأرسطية للمسألة، ولكن في قدرتها على استعمال مفاهيم ولغة جديدة، في تأملها لظواهر الحياة الطبيعية، تبعد تمامًا عن غموض لغة الأساطير والخرافات. فهناك رغبة ملحة في فهم ظواهر الحياة العصية على الفهم من خلال الملاحظة المباشرة للوقائع.
وتمثل فلسفة أنكسيمندريس خيرَ مثالٍ لتلك البراعة في تمثل ظواهر الحياة الطبيعية كنقطة انطلاق لفكره الفلسفي. فنتيجةً لانشغال أهل ملطية بالملاحة البحرية، كان هناك رصدٌ دائم للعواصف، حيث تتشكل سحب كثيفة سوداء يمزقها بغتةً برق منذر بزوبعة العاصفة التي توشك أن تهب. وفي محاولة أنكسيمندريس لتفسير ذلك، قال إن الريح المحبوسة في الغيم، شقت الغيوم بقوتها وعنفها، فتولد الرعد والبرق نتيجة لهذا الانشقاق المفاجئ. وبالتشابه مع حالة العاصفة تصور أنكسيمندريس حالة الطبيعة ككل، وكيفية تكون الكواكب والسماء. فقد كان يفترض وجود ثلاث طبقات دائرية من الهواء والأبخرة المتكاثفة، التي تخترقها النار مُكوِّنةً الظواهر الفلكية (الخسوف، والكسوف، وغيرها)، تمامًا كما تخترق الريح كتل الغيوم.
ونلاحظ هنا كيف ظهرت لغة الفلسفة الجديدة، التي تحاول تفسير الطبيعة والحياة من خلال ملاحظات واقعية مباشرة. وكما عبر «إميل برييه» عن ذلك ببراعة، فإن تشكل الكون لا يختلف اختلافًا جوهريًّا عن تشكل سحابة، فالواقع يفسر ذاته بعيدًا عن روايات الأساطير والآلهة.
وفي ضوء انشغال أنكسيمندريس بمظاهر الحياة، وبخاصة الحياة البحرية، استنتج أسبقية الحياة البحرية على الحياة البرية، بل عَدَّ الأولى سابقة على الثانية ومصدرًا لها. وقد افترض أن الكائنات الحية تولد في الرطوبة الحارة المتبخرة بفعل الشمس، فالأسماك والرخويات البحرية سابقة على الحياة البرية. كما أنه يفسر ظهور الكائنات البرية بأن الكائنات الحبيسة في قشور شائكة، تحتم عليها أن تؤقلم طراز حياتها حينما تكسرت القشور فوجدت نفسها فوق الأرض. ويُعدُّ ذلك أقدم حدس بنظرية التطور، جاء نتيجة انشغال كبير بمسألة نشأة الحياة.
كانت نظريات المدرسة الملطية وليدة تأمل عظيم لمسألة ظواهر الطبيعة وأصل الحياة. فلم يكن قول طاليس بأن الماء هو أصل الأشياء، في حقيقته، بحثًا عن «مادة الموجودات»، وإنما كان نتيجة تأمل طويل للرقعات البحرية وكيف تنشأ منها الحياة؟ فهو انشغالٌ بالأصل الذي بزغت منه الحياة ككل، حيث نراه في إحدى الشذرات يشبّه الأرض بسفينة فوق البحر.
لقراءة جميع مقالات سلسلة #الأصل:
أصل الحياة في الفلسفة اليونانية.. أمبادوقليس نموذجًا
فرضيات نشأة الحياة من وجهة نظر علم الأحياء.. البيضة أولًا أم الدجاجة؟

