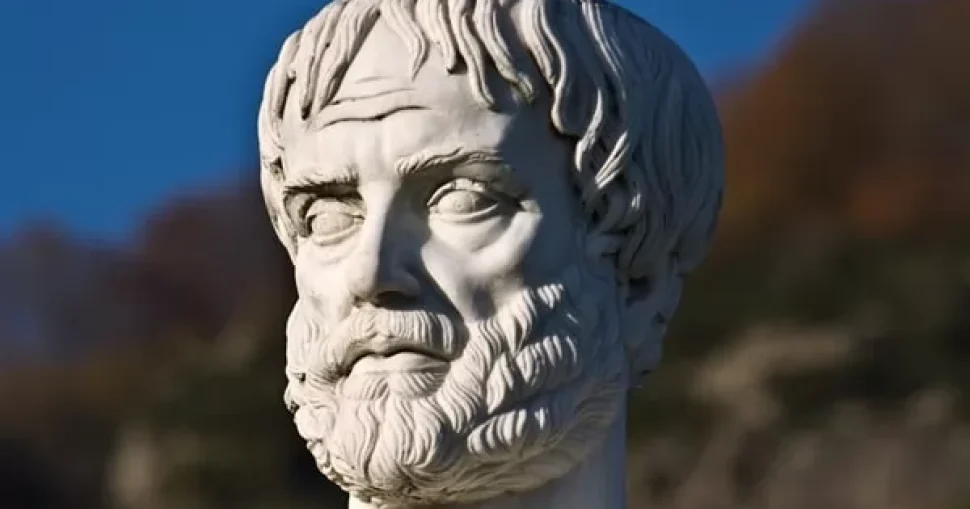استكمالًا للقراءة والعرض حول فلسفة المعلم الأول، سنُكمل جولتنا في بعض المباحث التي سلك أرسطو في معالجتها، وكما قولنا سابقًا أن ما يميز كتابات أرسطو، عامة؛ هو أسلوبه في تناول أفكار السابقين وتعليقه ونقده لمذاهبهم، لذاك سُمي أول مؤرخ للفلسفة، حتى قيل عنه: رجل موسوس بالتفاصيل يعيد ترتيب مفاهيمنا. كما أن ما يتضح لنا عن المنهج الأرسطي خلال قراءة أعماله هو منهج تاريخي يبتعد -غالبًا- عن ابداء أحكام عقلية وأخلاقية على الأوضاع سواء سياسي أو اجتماعي، بل يولج إلى فهم الواقع من خلال الوقائع والمشاهدات، ويحدد بوصلته عبر تعيين مقدمته الكلية، حيث يقول أن: “الطبع مبدأ كل شيء”، فهو يُعرف الانسان بأنه حيوان اجتماعي وسياسي. لأن المجموعات البشرية؛ “تناضل لكي تعيش معا حتى عندما لا تحتاج إلى مساعدة من بعضها البعض” (ليفي شتراوس)
وما سنتناوله في موضوعيّ الأخلاق والسياسة، واللذين لا غبار على أهميتهما في حياة الانسان واتصالهما ببعضيهما اجتماعيًا، بل وقيمتهما بين أعمال أرسطو، كما يقول ويل ديورانت: “إن كتابيه في الأخلاق والسياسة ليفوقان أمثالهما كلها في الشهرة وعميق التأثير حتى أيامنا هذه” (حياة اليونان-ك 4) فإذا كانت الأخلاق ترمي إلى سعادة الفرد، فإنه يرى في السياسة هو علم السعادة الجماعية.
-
الأخلاق النيقوماخية
ما نعرفه من أعمال أرسطو في علم الأخلاق، هم أربع كتب، أكبرهم وأشهرهم: الأخلاق النيقوماخية والتي يرجح صحة نسبها إلى أرسطو عن باقي الرسائل -بحسب برتراند راسل- ويرجح أن ذلك الاسم يرجع إلى ابنه، سواء أنه اهداه إليه، أم أن ابنه قام بنشره. تنقسم إلى عشرة مقالات، كما تعتبر كتب الأخلاق المنسوبة إليه أقدم مؤلفات نظرية من نوعها. (جورج سارتون)، ومواضيع مقالاتها تتنوع حول مسائل مثل؛ غاية الحياة والخير الإنساني والفضائل الأخلاقية والفضيلة العقلية والإرادة والشهوة واللذة والسعادة والصداقة… إلخ، فلنلقي نظرة على نقاطها الأساسية.
– غاية الحياة
بما أن الأخلاق علم عملي، أي يصدر عن مواقف وأفعال في المجتمع، لذا تكون بتعبير أرسطو: “كل فن، وكل فحص عقلي، وكل فعل، وكل اختيار مروّي، فهي ترمي إلى خير ما، لذلك وُسم الخير بحق بأنه ما إليه يقصد الكل” (يوسف كرم)، ولذلك فالمعنى أن كل المقاصد تحمل غاية تتوجه لها جميع الأفعال البشرية، وبذلك لابد من الانتهاء إلى غاية قصوى وخير أعظم وهي السعادة.
ولما كانت الأخلاق عند الاغريق هي السعادة الفردية، كان أرسطو على نفس النهج؛ يرى السعادة تتحقق في ثلاث درجات، تبعًا لتقسيم الحياة، إلى؛ الحياة الحسية أي اللذة في الثروة والجسد؛ فالثروة شرط خارجي للسعادة، واللذة هي تابعة للفعل وليست هدفًا في حد ذاتها إنما شرط كمال الموضوع. والفضيلة أعلى شأن في العلاقات الإنسانية.
والحياة السياسية أي القوة وممارستها وفضيلة الشرف، وأما الحياة النظرية، فهي في التعقل والتأمل. لذا كانوا يرفعوا قمة السعادة والخير في العقل، فإن؛ “الخير الأسمى لا يمكن أن يتحقق إلا في الحياة النظرية” (موسوعة الفلسفة، بدوي)، فالنظر هو فضيلة الألهة الوحيدة، ولأن العقل أسمى وظائف الإنسان “جزء إلهي”، فعمل العقل هو الخير بالنسبة للإنسان، والأخلاقية إنما هي في الحياة العقلية وفي معرفة الحقيقة، وتكون السعادة القصوى.
– الفضيلة
وقد ذهب أرسطو لتحديد الخير الأعلى الذي يلزم الانسان تحقيقه في نفسه، ويحصل فضائله من سعة النفس الإنسانية، ولأنه ميز الفضيلة إلى فضائل عقلية تكتسب بالتعلم، وفضائل أخلاقية تفطر بالعادة، حدد الربط بينهما، وذلك عبر وسيلة غلبة العقل بالمران، فبالمران يكون ضبط النفس وتحكيم العقل، وبهذا علق أهمية كبرى على العادة، وقال إن تعويد الإنسان العادات الطيبة هو السبيل الوحيد لتكوين الإنسان الطيب، إذ “لا يكفي أن تعرف الفضيلة، بل ينبغي أيضًا أن تُمتلك وتمارس” (إميل برهييه)، هنا تعني الأخلاق التمرن والتدريب على التحسن في المجتمع، وليست مجرد مثل عليا. أي أنها تعليم للصفوة وليس مجرد وعظ وإرشاد.
وعرّف أرسطو الفضيلة بأنها “ملكة اختيار الوسط الشخصي الذي يعينه العقل بالحكمة” (يوسف كرم) أي وسط بين طرفين.. فهي لا إفراط ولا تفريط، “فمثلا فضيلة كالشجاعة هي وسط بين إفراط هو التهور، وتفريط هو الجبن” (إميل برهييه)، وقد عاب على سقراط عدم الاعتبار لعامل الشهوة فقد يفكر جيدًا ويرشده فكره إلى الصواب، ولكن تتغلب عليه شهوته فتغويه.
– فضائل
ناقش ارسطو في الاخلاق النيقوماخية، عدة مناحي بما ترتبط بأهميتها في الاجتماع المشترك، كقيمة الصداقة وأهميتها اجتماعيا في ترابط المدينة والسياسة والعدالة: “وعندما يكون الناس أصدقاء فإنهم لا يحتاجون إلى العدالة، لكن عندما يكونوا عادلين فإنهم يحتاجون إلى الصداقة أيضًا.” (إميل برهييه)
ومن الملاحظ أن لأرسطو بعض الارتباط الطبقي في تناول الأخلاق، حيث ربط رفعة الأخلاق بالطبقات الميسورة، القادرة على الترفع: “من المتعذر على المعوز أن يأتي كريم الأفعال”.
كما نرى في مفهومه عن فضائل، كالعدالة، أن مباحثه الأخلاقية لا تحيد عن مذهبه في الطبع أيضًا، بمعنى أن مفهوم العدالة عنده، لا يقتضي المساواة؛ “بل مراعاة النسب الصحيحة، (…..)، فعدالة السيد أو الوالد تختلف عن عدالة المواطن، ذلك لأن الإبن أو العبد ملك، ولا يمكن أن يظلم الإنسان ما يملك” (برتراند راسل)
والعدالة تنقسم مع الدولة والقضاء، فمع الأولى توزع بحيث؛ “تراعى فضل الأفراد فتعطي كلًا قدر فضله”، بينما القضائية تعتبر الأطراف متساوية، تعوض الظلم الواقع، “فتأخذ الظالم بمثل ما أخذ به غريمه”، وهنالك ما هو أعلى من العدالة القانونية، وهو الإنصاف، حيث أن القانون بعموميته لا يستطيع أن يحيط بالأحوال الجزئية باختلافها، حتى من الممكن أن يكون تطبيق القانون على إحدى الحالات ظالما؛ “فالمنصف يقيم نفسه مقام الشارع، ويستوحي روحه، فيصحح نصه ويقضي كما كان الشارع يقضي لو كان حاضرًا” (يوسف كرم)
تتمثل نظريات الأخلاق لأرسطو كإرتباط وثيق بالسياسة، فكلاهما يخدمان بعضهما عنده، فما كتبه أرسطو في الأخلاق ليس كمبحث مستقل، بل مقدمات للدراسة السياسية: “إن العلم العملي له ثلاثة فروع: الأخلاق والاقتصاد والسياسة” (ليفي شتراوس)، كما أن موضوع الاجتماع السياسي هو فضيلة الأفراد وسعادتهم لا مجرد العيشة المشتركة فقط. فغاية العلم السياسي عند ارسطو هو الحياة الخيرة للفرد وللمجتمع السياسي. فكما أن الانسان جزء عضوي في الدولة، فإن علم الأخلاق جزء من علم السياسة، لذا تكون؛ “العلوم كلها والفنون كلها الغرض منها خير ما. وأول الخيرات يجب أن يكون الموضوع الأعلى للعلوم جميعها، وهذا العلم إنما هو السياسة. فالخير في السياسة إنما العدل، وبعبارة أخرى المنفعة العامة” (أرسطو) ولا تكتمل الأخلاق عند أرسطو بغير السياسة؛ “فلأجل أن يكون علم الأخلاق تامًا، يجب الكلام في العلم السياسي” (يوسف كرم)
-
في السياسة
كانت لخلفية أرسطو السياسية والاجتماعية طابعًا هاما في تكوين ملامح تفكيره، حيث نشأ في محيط مهد له، الاحتكاك بأهل السياسة، مما عاونه بلا شك، في القرب من تفكير الساسة والحكام، كما جعله على قدر من الإلمام بالتاريخ السياسي. وهو ابن «نيقوماخوس»، طبيب «امنتاس الثاني» ملك مقدونيا، نشأ منذ صغره في معية الملك. وقد كان صديق فيلبس ومعلم الإسكندر، ولازم هرمياس طاغية أطرنة.
وكما يذهب مؤرخي العلم إلى أن اليونان تلميذة العالم القديم؛ بابل وآشور ومصر.. إلخ، فإن أرسطو لم يقف عند جمع مدارس عصره بل قبع في أفاق علمه السياسي مذاهب قديمة في الأنظمة السياسية وفلسفتها، مثل تقسيم المصرين المواطنين لطبقات، والموائد العامة في كريت وإيطاليا، “ومصر شاهد على اثباته. فلا أحد يجادل في قدمها السحيق وفي كل الأزمان كان لها قوانين ونظام سياسي”، وقد درس مع تلاميذه دساتير مدن اغريقية قد تصل ل 158 دستورًا.
وقبل أن نعرض مذهبه السياسي، نشير إلى سمات منهجية رئيسية، لتعين الفهم الكلي، لنظرياته، حيث أنه ينتمي إلى موقف وضعي أكثر منه موقف فلسفي نظري -ولا يخلو من انحياز فلسفي بطبيعة الحال- فإنه أسس مبدأ رئيسي في كتابه “في السياسة” ألا وهو مبدأ الطبع، الذي يحدد على أثره وصف الإنسان، وطبيعية نشأة المدينة، والتي جاءت الأخيرة؛ استجابة لأراء معاصريه أن: “المدينة تناقض الطبيعة وتقوم نهائية التحليل على القوة” (شتراوس)
أما سبب بُعد مذهب أرسطو السياسي عن الشكل الفلسفي المعهود لأستاذه أفلاطون، هو أن السياسة عنده تندرج تحت العلم العملي الذي يعتمد على الانسان نفسه، بتعريفه كواعي ومسؤول وذو حرية إرادة؛ حيث “إن غرض العلم العملي ليس المعرفة، إنما تحسين الفعل” (شتراوس)، وعليه يستمد أرسطو استقراءه من أرض الواقع البشري المتغير، وليس نظريًا واستنباطيًا، بحيث أنه يجعل موضوعه موجه للسياسين العادين وليس بناء نظري فلسفي، وذلك لا يعني انفصاله عن وجود فلسفة سياسية: “فإن ما هو واضح تماما هو احجام أرسطو عن تأسيس علم عملي على أساس نظري بصورة جلية”، أو كما يحلل شتراوس؛ حتى لا يتأثر السياسي بحجج نظرية مقدمة تهمل الجوانب العملية. وبذلك أعطى ارسطو الواقع الكائن الأولوية في شرح أراءه؛ فنجده يقول: “إن نوعا من أنواع الحكم قد يكون أحسن من غيره من الأنواع، ولكن ليس ثمة ما يمنع أن يكون نوع آخر خيرًا منه في ظروف خاصة”
وذلك ما ذهب إليه عبد الرحمن بدوي؛ أن نظرية أرسطو في الدولة لا تتصل بالفلسفة اتصالا كبير، إنما هي أقرب إلى القانون. والفارق بين الدولة عند أفلاطون وأرسطو، أن الأول بدأ من منظور ما يجب أن يكون، والثاني بدأ من ما هو كائن.
وذلك النهج يبرر اتجاه النقد الواسع الذي قدمه على مدار الكتاب لفلسفة معلمه السياسية؛ “أفلاطون”، حيث أن الأخير اقتصر على تحليق العقل، لكن أرسطو نزل الى ساحة الحواس. مقررًا أن ما يوجد في النفس ما هو إلا انعكاسا لأشياء في الطبيعة. وبذلك قدم الأحداث الاجتماعية ووقائع التاريخ على العقل الفلسفي كما عند أستاذه.
وما سيأتي سنعرض ملخص لأبرز النقاط الواردة في كتابه: في السياسة، الذي يقسم إلى ثمانِ أجزاء، وسأتعمد تقليل التعليق على متنها.
الكتاب الأول: الاجتماع المدني – الرق – الملكية – السلطة العائلية
يخلص تحليل أرسطو في تقرير تراتبية الوجود الإنساني، كالتالي؛ أن المدينة، أي الدولة ذات وجود طبيعي أي أن بقاءها من حاجات الحياة، فيقول: “أن الدولة هي من عمل الطبع، وأن الإنسان بالطبع كائن اجتماعي”، وذلك الاجتماع مقدم على مصلحة الفرد، لأنه يهدف للخير الأعم للجميع، وأما مكون المدينة، فهي القرية “المستعمرة الطبيعية للعائلة” التي تتألف من عنصر العائلة، والذي يسري عليه مبدأ الطبع، حيث؛ “الاجتماعان الأولان بين السيد والعبد وبين الزوج والزوجة هما قاعدتا العائلة”، ويحل علاقة البشر التراتبية، على أنها من طبائع الأمور، كالتناسل والتكاثر، ليذهب إلى تقرير وجود كائنات أمرة وأخرى للطاعة، فيقول:
“كما أن الطبيعة هي أيضًا التي أرادت أن الكائن الكفء بخصائصه الجسمانية لتنفيذ الأوامر يطيع بوصفه عبدًا. وبهذا تمتزج منفعة السيد ومنفعة العبد”
أما بالنسبة لأعلى فضيلة للاجتماع السياسي تكون في العدالة، وقد تحدثنا عن مفهموها أعلاه في الاخلاق، فهو يقرر أن: “العدل ضرورة اجتماعية لأن الحق هوا قاعدة الاجتماع السياسي وتقرير العادل هو ذلك الذي يرتب الحق”، لكنه يجانب موقف العدالة الوضعية في قول جماعة السوفسطائية، منحازًا للعدالة الطبيعية، لكنه فشل في ضرب أمثلة عن العدالة الطبيعية بحسب قول “كارنز لورد”.
وفي تحديد موقف أكثر تفصيلًا في روابط العائلة، يقرر أرسطو نظريته في الرق بناءًا على طبيعة التفاوت بين البشر، بل أن؛ “الأمرة والطاعة ليسا شيئين ضروريين فحسب بل هما أيضًا شيئان نافعان كل النفع”.
ومع الرغم من وجود اتجاهات معاصرة له ترد العبودية إلى فعل القانون الجائر المبني على العنف، أي أن سلطة السيد غير طبيعية. إلا أن أرسطو دلل على طبيعة السلطة على الأخر من خلال قياس علاقة النفس بالجسد والعقل على الغريزة، والرق الطبيعي ليس كل ما هو موجود في الواقع، فقد يحدث أن لا يستحق أناس العبودية ولا يستحق أخرون الحرية. كما أنه يرى فضائل كالحكمة والشجاعة والعدالة للأحرار، لكنه لا يرى أن يمنع العبيد من ذلك، فلهم نصيب من العقل!
“نقرر أنه يوجد بفعل الطبع عبيد وأناس أحرار. ويمكن أن يؤيد أن هذا التمييز يبقى قائمًا كلما كان نافعًا لأحدهما أن يخدم باعتباره سيدًا. بل يمكن أن يؤيد آخر الأمر أنه عادل وأن كلا يجب عليه، تبعا لمشيئة الطبيعة، أن يقوم بالسلطة أو أن يحتملها. وعلى هذا فسلطة السيد على العبد هي كذلك عادلة ونافعة.”(ص106)
وتتوزع التراتبية داخل العائلة بين السلطة والطاعة، حيث إدارة العائلة ترتكز على سلطة السيد والزوج والأب؛ إذ “الكائن الأكبر والأكمل هو الذي يتأمر على الأصغر والأنقص”، أما الطاعة درجات، بحسب الإرادة؛ “فالعبد مجرد على الاطلاق من الإرادة، والمرأة لها إرادة لكن في درجة أدنى، والولد ليس له إلا إرادة ناقصة”.
وفي الباب الثال؛ تناول الملكية الطبيعية وكسب الأموال، في ضوء مبدأ غائية الطبيعة، عرض طرائق الكسب المختلفة من الزراعة او الصيد او الغنيمة او الرعي او السلب، وأساسه العمل الشخصي الطبيعة لا تخلق من شيء عبثا، والحرب وسيلة طبيعية ومشروعة للكسب مثل الصيد الذي يصطنعه الانسان للوحوش.
وأما الأموال فهي ليست من الطبع بل نتاج الفن والتجربة، فالملكية الخاصة يا إما للمنفعة أو المعاوضة، والتبادل الطبيعي يكون لسد الحجات فقط. ويقول أرسطو عن الثروة المالية:
” كسب المال ليس موضوع الشجاعة التي لا ينبغي أن تعطينا إلا أمنا حصينا، وهو ليس كذلك موضوع الفن الحربي ولا فن الطب اللذين ينبغي أن يعطينا أحدهما النصر والآخر الصحة. ومع ذلك فالناس لا يجعلون من كل هذه المهن إلا مسألة مالية كما لو كانت هذه هي غايتهم الخاصة، وأن كل ما فيها يجب أن يرمي إلى بلوغ هذه الغاية”.
الكتاب الثاني: نقد النظريات السالفة والدساتير الرئيسية
أفرد أرسطو أوجه من النقد للنظريات السالفة والدساتير الرئيسية، وبدأ بتوجيه أسهم النقد لجمهورية أفلاطون؛ حيث ساغ نقده على أساس أنه لا يوجد نموذج في الواقع يدل على قابليتها وصلاحية انشاءها.
برى أرسطو في مذهب أفلاطون أن في ظاهره محبة الإنسانية: “فإنه أول وهلة يسحر اللب بالتكافؤ العجيب للرعاية الذي يجب فيما يظهر أن يوحى به إلى أهل المدينة أجمعين”
وأما ما يقف عليه مع أفلاطن هو أن للأفراد ملكية فردية وتنوع واختلاف، لا يستقيم مع الوحدة السياسية القائمة وما بها من شيوع للملكية؛ ” إن الوحدة لا تنتج إلا من عناصر أنواع مختلفة، ومن أجل ذلك كان التكافؤ في المساواة”، كما أن صفات مثل السخاء والكرم والعفة، لا توجد إلا بتواجد الملكية والحيازة.
. فالخير الأسمى للدولة هو اتحاد أعضاءها. “للإنسان باعثان كبيران للرحمة والمحبة وهما الملكية والعواطف”
يتناول أرسطو دستور فلياس الخلقيدوني، فيقول أنه أول من قرر مبدئيا أن المساواة في الثروة بين أهل المدينة أمر لابد منه.
وفي موضوع تنظيم الملكية، التي هي موضوع أصيل عند المقنين، لأن إختلالها مصدر الثورات، فمع أنه يتفق أن مساواة الثروة تنفع حقا في اتقاء المنازعات الداخلية، لكنه يرى أن قبل المساواة في توزيع الثروات، يجب؛ ” هي أن يسوى بين الشهوات أولى من أن يسوى بين المليكات، وتلك المساواة لا تنتج إلا من التربية المنظمة بالقوانين الطيبة”
ويتناول أيضًا دستور إبوداموس الملطي، حيث يتناول نقطة التجديد في القانون، حيث أن القانون المكتوب من اهداء العقل، وبالتالي هو غير ثابت، وكما أن نص القانون يكون بوجه العموم، فلا يلم بكل الحالات الخاصة؛ والنتيجة الضرورية لهذا هي أنه في بعض الأحقاب يلزم تغيير بعض القوانين، لكن مع ذلك تكون “الخفة في استبدال قوانين جديدة بالقوانين الموجودة إنما هي إضعاف لقوة القانون ذاتها على قدر سواء”
كما انتقد دستور لقدمونيا (اسبرطة)، بأن؛ “الدولة لا يمكن أن تجد من سلام إلا في توافق أهلها على أن يريدوا لها الوجود والبقاء”، وأقام التشابه بين دستور كريت ودستور اسبرطه
يقترح ارسطو نظام قانوني مختلط بين الديموقراطية والأرستقراطية، الانتخاب لملاك الأراضي، وتكون هنالك طبقة وسطى قوية وعريضة هي مصدر السلطة، ويقدم حكم القانون على الفرد، فهو العقل مجرد عن الشهوة.
الكتاب الثالث والثامن: السيادة – نظرية الثورة
في السيادة، يؤيد أرسطو سيادة القانون المؤسس على العقل، ويرى صلاح القانون من صلاح الحكم. وحيث أنه من العدل أن يسند القانون السيادة إلى الجمهور بدل الأفراد أو الأقليات أي الأكثرية، فالفرد له نصيب من الحكمة، وتكون مفيدة بإجتماعهم كرجل واحد، لكنه يحدد مهام الجمهور، حيث يرى أن يترك لهم حق الشورى في الأمور العامة وحق الحكم في القضايا، لكن لا يوكل إليهم الشؤون الهامة، إذ يقول: “إن الجمهور فرادى لا يحسنون الحكم كما يحسنه العلماء، أوافق على هذا، لكنهم وبجمعهم إما أن يفوقوهم أو أن يساووهم” وذلك من منطلق أن؛ “الطاعم لا الطاهي هو الذي يقدر قيمة الوليمة”، كما يدلل على عدالة أن يكون نصيب الجمهور أوسع من السلطان لأنهم يؤلفون الشعب ومجلس الشيوخ والمحكمة.
وفي نظرية الثورة، يرى أنها تحدث، بناءًا على طبيعة كل مذهب، كالديموقراطية التي تسعى لجعل السلطان العام موزعا بالتساوي، بينما تذهب الأوليغرشية إلى الامتيازات وطابع اللا مساواة. حينما لم يحصل أيًا منهما على أمر سياسي، نزعوا إلى الثورة.
ويرى أن “اللامساواة دائما هي علة الثورات، حينما لا يعوض عنها أولئك الذين تصيبهم”، وإذ به يذهب إلى استنتاج أن الديموقراطية هنا أشد استقرار وأقل عرضة للثورات من الأوليغرشية. حيث؛ “إن الاشكال الديموقراطية هي الأشد متانة لأن الأكثرية هي التي تسودها وأن تلك المساواة التي يستمتع بها فيها تجعل الدستور الذي يؤتيها أثيرًا عند أهلها. على ضد ذلك الأغنياء متى كفل لهم الدستور استعلاء سياسيًا لم يعنوا إلا بإشباع كبريائهم وطمعهم”
وأما ما يراه، من موانع قيام الثورات، أولا هو إدماج الفقراء والاغنياء إدماجا تاما أو بزيادة الطبقة الوسطى، “إنما هو هكذا تمنع الثورات التي تتولد من اللامساواة”، ثانيا أن الدولة الحسنة أن لا تخالف القانون في شيء، حيث يجعل ذلك فئة المواطنين التي تريد ثبات الحكومة أشد قوة من التي تريد سقوطها.
كما نبه إلى أهمية التربية وفقا لمبدأ الدستور، فيقول: “إن أنفع القوانين، أي القوانين المصدق عليها بإجماع المواطنين”
ولكي تحدث ثورة، يجب أن يوجد استعداد نفسي للثوار، ويكون هناك هدف من الثورة، وتكون ظروف تكوينها ممكنة. كما أن استمرار الحكم المستبد يقوم على الحرص على عدم ثقة المواطنين بعضهم ببعض، وإضعاف استعدادهم النفسي، وتسفيل أخلاقهم.
أخيرًا، نجد أعمال أرسطو في السياسة والأخلاق، أصيلة وممتدة عبر التاريخ، حيث كان من شراح أرسطو ومؤرخي علمه السياسي، في العصر القديم “فولو بيوس وشيشرون”. والذين كانوا من مصادر ميكافيللي وبوسوى مونتسكيو.